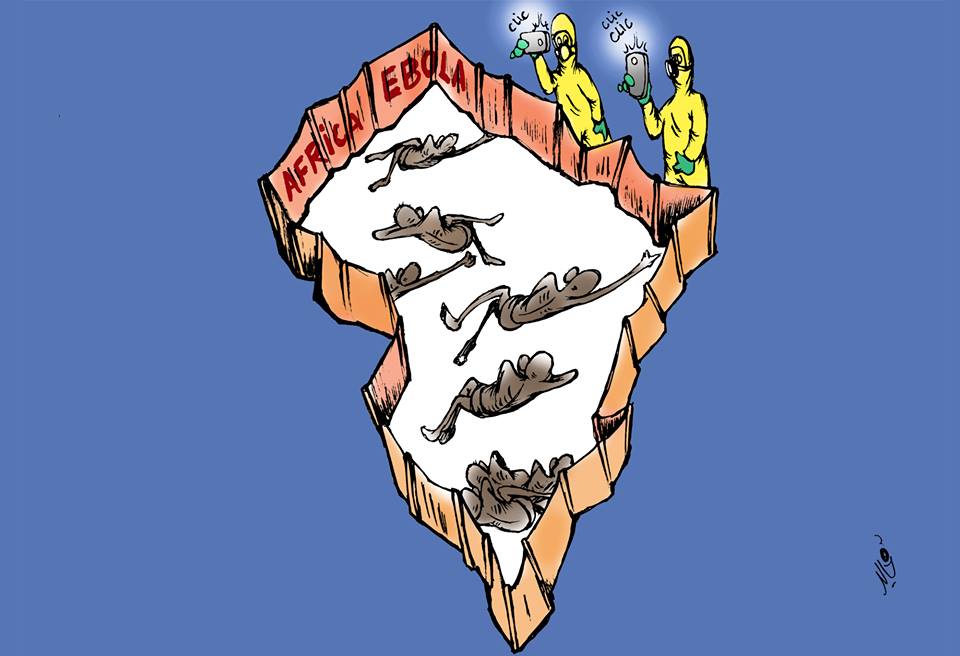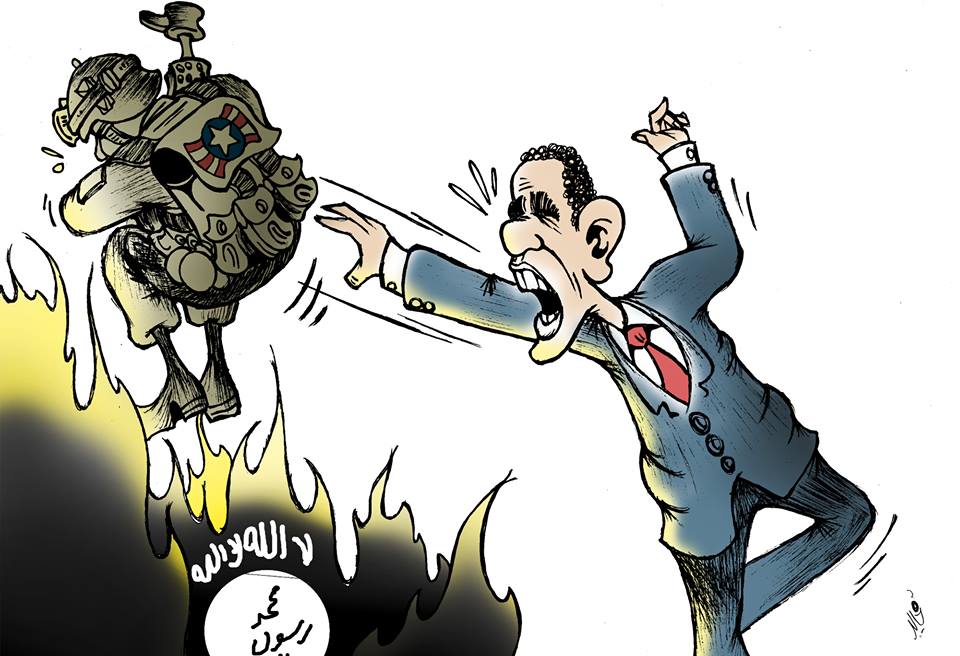الأسئلة القلقة في تاريخ المغرب (1)
في توضيح السياق، أسئلة التاريخ بين طابوهات الدولة وحاجات المرحلة:
عندما يظل التاريخ محل أخذ وردّ، فذلك مؤشر على عدم استقرار الوضع بصفة نهائية، وعدم الحسم في الاختيارات بشكل يضمن لكل المكونات مكانتها الطبيعية، ويهتدي معه المسؤولون والنخب وأصحاب القرار، وكذا القوى الفاعلة في البلاد، إلى الخطاب الذي ينبغي اعتماده باعتباره تمثيليا متوازنا، يلقى قبول كل الأطراف والمكونات الوطنية. يفسّر هذا الأسباب التي جعلت التاريخ موضوع نقاش عمومي متوتر، رغم تعديل الدستور والاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية للبلاد، وبالأمازيغية مكونا مركزيا للهوية الوطنية.
فالدستور المغربي لم يحسم النقاش لسببين:
ـ تناقضاته التي خلقت الكثير من التشويش، وفتحت الباب أمام التأويلات المتباينة والمتباعدة.
ـ استمرار السلطة والمسؤولين في استعمال مفاهيم الخطاب الرسمي وشعاراته السابقة، في تجاهل واضح للدستور المعدّل.
ولعلّ موضوع تاريخ الدولة المغربية وبداياتها في المرحلة الإسلامية، وشخصية ادريس الأول والثاني ورمزيتهما في الخطاب الرسمي الشائع، كانا من أهمّ الأمور التي مازالت تثير المواجهات الفكرية والسجالية، بسبب كونهما ـ بجانب قضايا أخرى ـ من الأمور التي استعملت في السياق السابق وخلال سنوات الرصاص، وما زالت تستعمل حتى الآن بين الفينة والأخرى، من أجل تحجيم الخطاب الأمازيغي ورذعه سياسيا وإيديولوجيا.
لكنّ الذي لم تقم السلطة وحلفاؤها بحسابه بدقّة هو أن السياق الوطني والعالمي كان ماضيا نحو التطور في اتجاه تجاوز الأسس التقليدية للدولة الوطنية المركزية، حيث أصبح الوعي بعناصر التنوع والاختلاف وعمق تجذرها أكثر مصداقية، وكان لزاما في معترك الصراع ضدّ ثوابت الايديولوجيا الرسمية، تفكيك الأساطير المؤسسة للشرعية السياسية للدولة المركزية، التي دفعت نحو الهامش بالعديد من عناصر التنوع العريقة، معلنة "ثوابت" اعتمدتها في صناعة هوية جديدة للدولة الناشئة بعد الاستقلال، وذلك عبر عملية انتقاء لعناصر هوياتية وإغفال أخرى باعتبارها مهدّدة للإنسجام والتجانس المطلقين، حيث كان هذا "المونتاج الهوياتي" وحده في نظر السلطة، ما يمكن أن يكون أساسا متينا للوحدة الوطنية.
هذه هي نقطة التوتر في موضوع شخصية ادريس وقضية ما يُسمى "دولة الأدارسة" عموما، فالمرامي السياسية لاستعمال رمزية ادريس ونسبه هي إضافة إلى أهداف تعريب الدولة والهوية، التأسيس لشرعية الأسرة الحاكمة (العلويون)، عبر ربط الماضي بالحاضر، وجعل الدولة المغربية مرتبطة في أساس إنشائها بالبيعة لآل البيت، وهي شرعية لم تعد تتناسب مع الشعارات التي تعلنها السلطة نفسها، مثل "المجتمع الحداثي الديمقراطي" و"الانتقال الديمقراطي" و"المساواة على أساس المواطنة" إلخ..
وقبل أن نخوض في موضوع شخصية إدريس بن عبد الله وتأسيس الدولة الإدريسية اللذين يثار حولهما النقاش حاليا ـ كما كان عليه الأمر دائما على مدى نصف قرن الأخير ـ أودّ التأكيد من باب توضيح السياق على الأمور الهامة التالية:
أولا يبدو أنّ بعض الذين أدلوا بدلوهم في هذا النقاش لم يستوعبوا جيدا سياقه وأبعاده، ولا منطلقاته وأهدافه، ومن تمّ لا بدّ أن نذكر أن إعادة قراءة تاريخ المغرب ـ التي هي ضرورة تعترف بها السلطة نفسها ـ إنما تتمّ في إطار ما نُعت بـ"المصالحة الوطنية" والسعي إلى الإصلاح والترسيخ الديمقراطي. وهو ما يعني أننا بصدد نقاش سياسي وليس أكاديمي محض، وإن كان له بعد علمي ذو صلة بالوثائق والمرجعيات والتحاليل والقراءات. فموضوع التاريخ حينما يتمّ الخوض فيه في مناخ متوتر، فإنما يتمّ ذلك في البلدان التي تعرف مراحل انتقالية من أجل إنصاف كل مكونات الأمة، والوصول إلى رواية لا تسمح باعتماد التاريخ من أجل الإضرار بهذا الطرف أو ذاك. وهو ما يعني أنّ النقاش في التاريخ وراءه صراع ذو طبيعة سياسية إيديولوجية، منشأه حالة من حالات الظلم أو الحيف التي يراد رفعها وتصحيحها، فالنقاش حول مذابح الأرمن مثلا والتي ارتكبت من قبل الجيوش العثمانية ليس نقاشا علميا محضا، وكذلك النقاش حول الطريقة التي أنشئت بها الولايات المتحدة الأمريكية، دون الحديث عن محرقة اليهود في العهد النازي أو الطريقة التي قرأت بها الحركة الوطنية المغربية ظهير 16 ماي 1930، هذه الأمثلة كلها وغيرها ما زالت تطرح على الباحثين المتخصّصين أسئلة عديدة، من أجل التنقيب عن المعطيات المغيّبة أو المهملة أو إعادة القراءة في بياضات النصوص وتناقضاتها، وهو عمل ينبغي أن يتمّ في الجامعة من طرف متخصّصين، كما تطرح على الفاعلين السياسيين والمدنيين مسؤولية اعتماد تلك المعطيات من أجل الدفاع عن قضية أو قضايا، وهو عمل يتمّ في المجتمع وفي منتديات النقاش العمومي ووسائل الإعلام.
من هذا المنطلق المشار إليه فإنني لا أخوض في هذا النقاش من منطلق كوني باحثا أكاديميا في التاريخ، ولكن من منطلق الفاعل السياسي والمدني الذي يهتم بأشكال توظيف التاريخ وأساليب ومستويات استعمالاته السياسية والإيديولوجية، كما هو الأمر بالنسبة للدين مثلا، حيث إن لم أكن فقيها متخصّصا في الدين، إلا أنني ناقد لأشكال استعمالاته وتوظيفاته الإيديولوجية والسياسية.
ثانيا أن النقاش حول التاريخ يكون في غاية الصعوبة في بلد قامت فيه شرعية السلطة على رواية تاريخية معينة، هدفها تكريس "ثوابت" نظام سياسي، حيث تصبح كل مناقشة لفترات تاريخية معينة تعني عند حراس الثوابت الرسمية الرغبة في نزع الشرعية أو التشكيك فيها، مما يؤدي إلى إذكاء الصراعات المختلفة.
هذا الخوف من التاريخ هو من العلامات البارزة للجمود العقائدي وللإرتباك والتردّد، في حين يعدّ تكسير الطابو التاريخي من أكبر علامات المضي إلى الأمام، والحسم في تطليق مساوئ الماضي، والتعبير عن الإرادة في فتح عهد جديد حقاّ. وإذا كانت السلطة ومن يدور في فلكها مُصرين على الإستمرار في التشبث بشرعية قائمة على تاريخ انتقائي، أو على تأويل سياسوي طبقي للتاريخ، فإنّ ذلك يعدّ من مظاهر عدم الإستعداد لبناء شرعية ديمقراطية تتجاوز كلّ الطابوهات، كما يدلّ على أنّ تجذر تقليدانية السلطة ما زال يشكل عائقا رئيسيا أمام إنجاح الخيار الديمقراطي.
ثالثا أن التاريخ بسبب ما ذكرنا لا يعني فهم الماضي فقط بل الحاضر أيضا، حيث أن نظرتنا إلى التاريخ تعكس الكثير من توترات الحاضر وتستجيب لحاجاته، مما يفسر سعي الإنسان الدائم إلى إعادة قراءة التاريخ وتفسيره وتأويله، ويبرز بالتالي عدم وجاهة الرأي القائل بضرورة طمس السؤال التاريخي أو تأجيله بسبب الحساسيات السياسية أو الدينية أو العرقية والإثنية، أو الاكتفاء باجترار الرواية الرسمية السائدة تجنبا للمشاكل.
فإذا لم تكن نصوص التاريخ المكتوب تتغير فإنّ قراءاته من منطلق حاجات الحاضر تتغير وتختلف حسب السياق، غير أنّ إعادة قراءة التاريخ تعبر عن درجة نضج الحاضر ورغبة أهله في التجاوز والتجديد والتطوير والمضي نحو المستقبل.
من منطلق هذه التوضيحات نودّ طرح بعض الأسئلة المتعلقة بتاريخ المغرب، وخاصة منها ما يتعلق بالتاريخ الماقبل إسلامي، و تاريخ بدايات تأسيس الدولة بالمغرب في المرحلة الإسلامية، ثم أسئلة العصر الحديث وفترة الحماية، وخاصة تاريخ بعض الوثائق كالوثيقة التي نعتت بـ"الظهير البربري"، ووثيقة "المطالبة بالاستقلال"، ووثيقة "إكس ليبان"، وغرضنا البحث في سياقات هذه الوثائق والروايات التاريخية المتعلقة بها وخلفياتها الّإيديولوجية والسياسية.