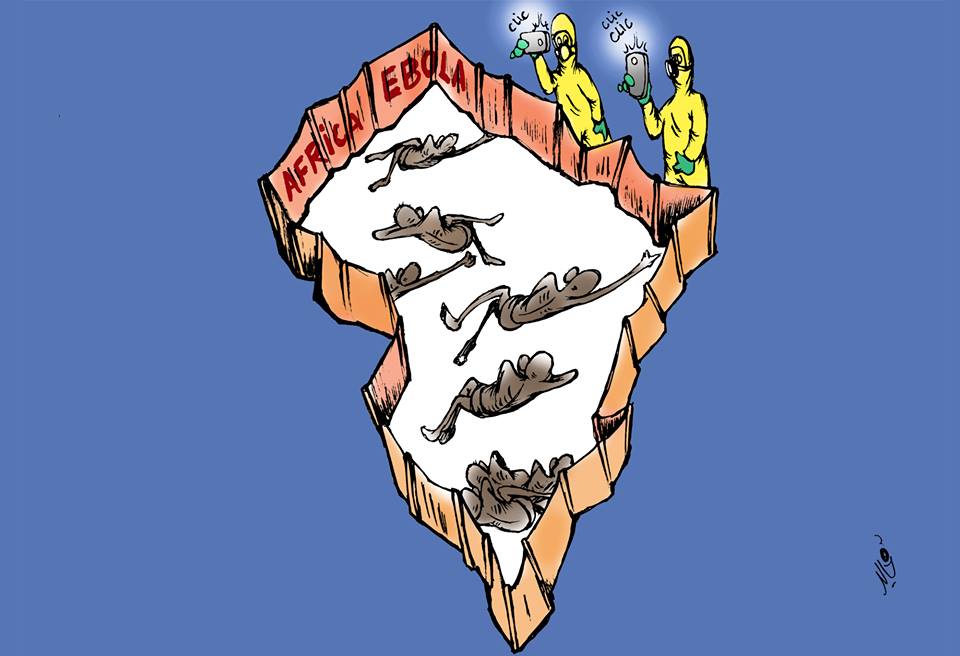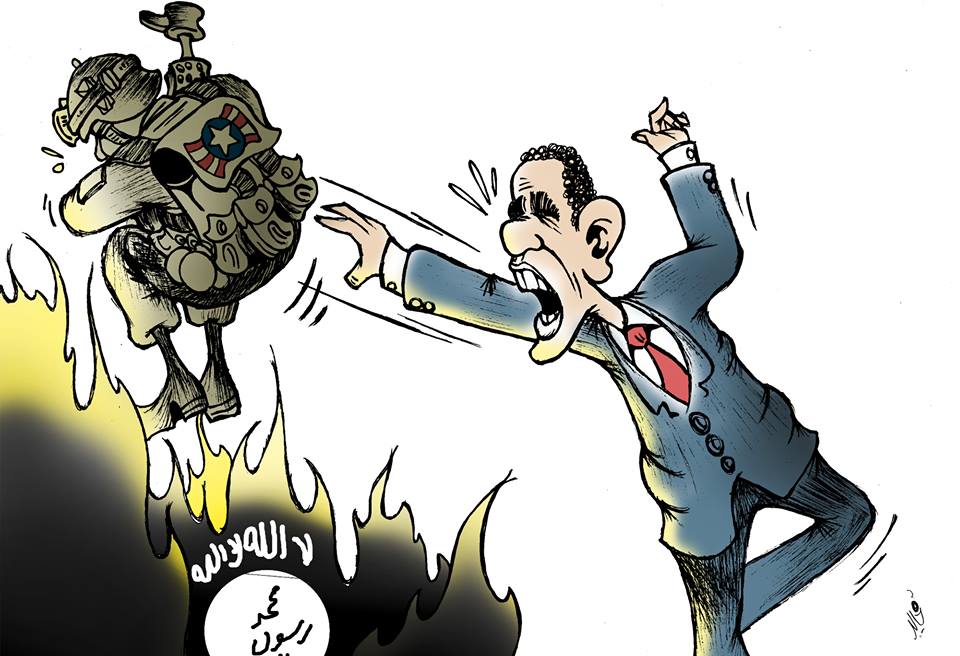توظيف الجسد بين الوعي التقليدي والوعي العصري
عندما نضع تصريح وزيرة الأسرة السيدة بسيمة الحقاوي حول "حيوانية الجسد"، (التصريح الموجه ضدّ حركة "فيمن")، بجانب تصريح السيد وزير الشؤون العامة بوليف حول "الخطوط الحمراء" للعُري، ونضيف إليهما بعض توابل ما كتبه السيد محمد يتيم وما ينشر على صفحات جريدة "التجديد" ضدّ الحريات الفردية، نجد بأن الوعي التقليدي الذي يعتمد منظومة الأخلاق الدينية ما زال عاجزا عن إدراك طبيعة العلاقة بين الجسد والفكر والوعي الإنسانيين في السياق الحضاري الراهن.
فالجسد في الوعي الديني لصيق بالغريزة، ويمثل كتلة حيوانية من المادة مليئة بالشهوانية والنزوعات الشيطانية، كما يتميز بـ"الدنس" بسبب إفرازاته من الفضلات أو من "دم الحيض والنفاس"، ولذلك يرتبط الجسد في الفقه الإسلامي بشكل كبير بمفاهيم "المعصية" و"الذنب" و"الفسق" و"الفجور" كما يرتبط بـ"الدنس" الذي يقتضي نوعا من "التطهر".
و"التطهر" ليس اغتسالا عاديا بل يندرج ضمن طقوس العبادة التي تحدّد وصفات محدّدة لطريقة تنظيف الجسد، ولهذا يميز الفقه بين النظيف و"الطاهر"، حيث قد يغتسل إنسان يوميا أو مرتين في اليوم، دون أن يُعتبر "طاهرا" بالمنطق الديني، وقد يلمس آخر قليلا من الماء في إناء ولا يبدو نظيفا في جسده أو ملبسه ويعتبر نفسه رغم ذلك "طاهرا".
ونظرا لجموح الجسد وشيطانيته فإنّ الإيمان والتقوى والخوف من ارتكاب المعصية والذنب ومن العقاب الأخروي، هي وحدها المشاعر التي تمكّن من إلجام هذا الجموح الحيواني وإيقافه وضبطه. ونظرا للوضعية الدونية للمرأة في المجتمع الباترياركي القديم، فقد انصبّت على جسدها نقمة الفقه الذكوري الذي لا يرحم، فغشته بأنواع القماش الأسود والبنيّ والرمادي، درءا للشهوات وتحصينا للمؤمنين من الوقوع في "المعصية". ولم يكن الجسد الأنثوي يفلت من سجن الألوان الداكنة إلا من أجل الغناء والرقص ذي الإيحاءات الجنسية، والموجّه أساسا لإمتاع الرجال. حدث هذا في عالم المسلمين كما حدث في الثقافات الأخرى، لكن تحولات الوعي والعلاقات الاجتماعية والحضارية وتفكك الروابط القديمة لم تقف عند هذا الحدّ، بل تجاوزته منذ زمن بعيد.
ولقد أدت الثورات العلمية والتحولات السوسيوثقافية المذكورة والتي حدثت خلال القرنين الأخيرين على الخصوص، والتي ساهم فيها الطب والتشريح والبيولوجيا، وكذا التحليل النفسي والأنثروبولوجيا الثقافية، إلى تبلور فلسفة جديدة للإنسان وللجسد، سرعان مع تسربت بالتدريج نحو المجتمعات الإسلامية ما بعد المرحلة الكولونيالية، والتي عرفت بدروها انقلابات كثيرة في بنيات العلاقات والسلوكات وأنماط الوعي، وهو ما أثر بشكل كبير في أشكال توظيف الجسد في المسرح والسينما والإشهار، بعد أن كانت توظيفاته محصورة في أشكال التعبير التقليدية.
لم يعُد الجسد رهين الثنائية الميتافيزيقية القديمة التي تجعل منه امتدادا ماديا مفصولا عن "الروح" أو "النفس" المؤمنة التي ترقبه وتلجمه، بل أصبح لا ينفصل عن ماهية الإنسان، وأصبح في تمظهراته يمثل أفكارا ومواقف ويبعث برسائل، خارج منطق "الشهوة الشيطانية". وبينما يرى الحداثيون في لغة الجسد كل تلك الآفاق والأبعاد الفكرية والثقافية، لا يرى منه المحافظون إلا نداء الشيطان، كما يفضلون فصله عن أي خطاب إنساني، ولهذا يربطونه بـ"الحيوان" رمز الغريزة الخالصة. وهذا ما يفسر استهجان التيار الإسلامي للدور الذي قامت بأدائه الفنانة لطيفة أحرار في إحدى مسرحياتها، كما يفسر تصريح السيدة الحقاوي ضد حركة "فيمن"، هذه الحركة وغيرها التي كان منتظرا أن تنتعش مع مجيء الإسلاميين إلى السلطة، إذ تمثل في الحقيقة نوعا من المقاومة من موقع دفاعي، تنطوي على تخوفات من أية عودة إلى الوراء، بينما يعتبرها المحافظون هجوما على المجتمع وانتهاكا لقيمه الأصيلة.
يعتقد الإسلاميون والمحافظون عموما بأن الأقليات الشبابية الجديدة إنما هي نتاج "التقليد الأعمى للغرب"، وأنها تمثل "ظواهر غريبة عن مجتمعنا المحافظ "، وأنها حالات شاذة معزولة، لكنهم ينسون بأن الذين يقومون بهذه العملية يعيشون أيضا يوميا ـ وفي بلدهم المغرب ـ حياة على النمط العصري الذي غزا جميع مجتمعات العالم، فالشباب الذي يثور باستعمال الجسد لا يتخيل أنه يقوم بذلك في مجتمع غريب عنه، بل يعتبر أنه يعكس وعيه الخاص الذي يعيش به يوميا في هذا المجتمع الذي يقول عنه إنه محافظ لا يقبل التعرّي أو غيره من الظواهر، يدلّ هذا على أنّ هذه المجتمعات المسماة محافظة ملزمة طال الزمان أو قصر بأن تتنازل لصالح القيم المعولمة، ليس لأن الجميع سيتبنى حتما تلك القيم والسلوكات، بل لأن ثقافة الاختلاف ستترسّخ أكثر، وستجعل الجميع يقبلون أن يعيشوا خارج أي تنميط أوحد، بما في ذلك التنميط الذي تقوم به العولمة الثقافية نفسها، حيث تعدّ مظاهر التديّن الخارجية كاللباس والسلوك التقليدي الديني من مظاهر مقاومة الأفراد للنمط الثقافي المعولم، هذه المقاومة المشروعة على المستوى الفردي لا يمكنها بدورها أن تتحول إلى محاولة لتنميط المجتمع بكامله وتعليبه في نموذج قيمي وحيد وقديم بحُجة مواجهة العولمة أو الوفاء للتقاليد.