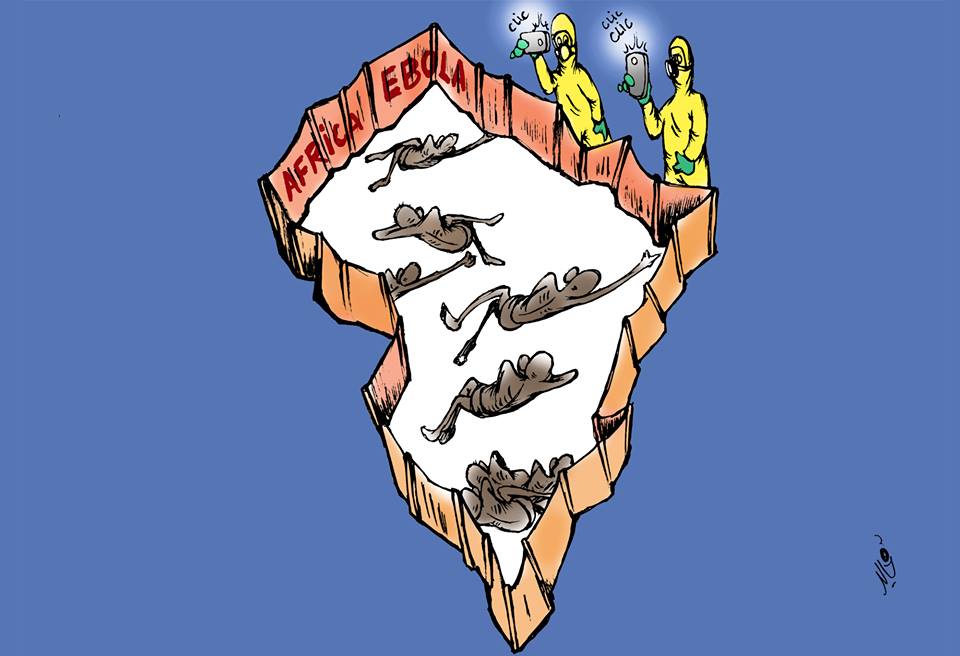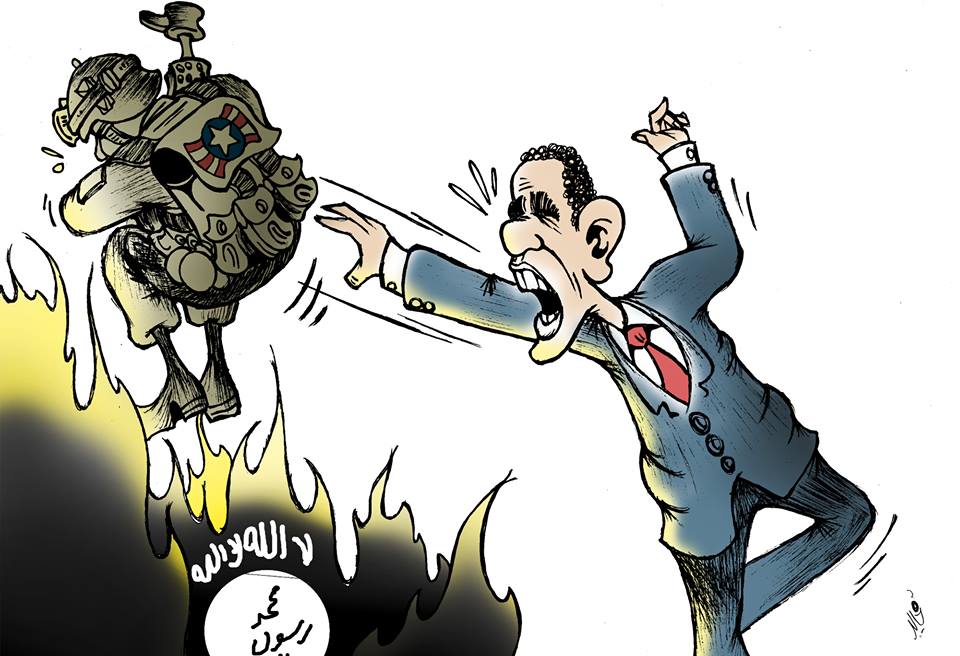خسائر ديمقراطية الأغلبية العددية
مازالت الديمقراطية التمثيلية العددية، ديمقراطية الأغلبية المهيمنة ضد الأقلية المستضعفة، تشكل حجر عثرة في طريق بناء دول الثورات في بلدان الربيع الديمقراطي، وهي البلدان الخارجة لتوّها من مرحلة طويلة طبعها استبداد سياسي مزمن، ولم تعرف مجتمعاتها التربية على الديمقراطية قيما ومبادئ كونية وإنسانية، تقوم أساسا على التدبير السلمي للتعددية، وعلى احترام الاختلاف وحماية الحقوق الأساسية.
يشير هذا إلى صعوبة اعتماد الديمقراطية آلية شكلية بدون مضمون فكري وقيمي، كما يفسّر حرص التيار المحافظ ـ الرافض في حقيقة مشروعه للديمقراطية ـ على اعتماد آلية صناديق الاقتراع وحدها بشكل يعفيه من احترام حقوق الآخرين ومكتسباتهم، ويحرّره من أي التزام قيمي في إطار الحداثة السياسية وحقوق الإنسان.
فبعد مصر التي عرفت هزة 30 يونيو، التي كانت نتيجة الطبخة المتسرعة لدستور "الإخوان"، يأتي الدور على ليبيا التي شهدت انسحاب أمازيغ هذا البلد احتجاجا على محاولة القوميين العرب والإسلاميين إلزامهم بالخضوع لما تقرره الأغلبية، حتى ولو كان به إنكار تام لحقوقهم، وهم الذين دخلوا طرابلس حاملين الأعلام الليبية، محرّرين كل غرب ليبيا من مليشيات القذافي، وأظهروا حسا وطنيا راقيا بامتناعهم عن السعي إلى الهيمنة أو إحداث الأضرار بالممتلكات أو الاستقواء بالسلاح أو اللجوء إلى العنف حتى في حالات الغلبة.
عاش أمازيغ ليبيا أحلك فترات تاريخهم في ظل حكم القذافي، كانوا فيها محرومين من أبسط حقوقهم التي تصون كرامتهم، وكانت فيها هويتهم مرادفة للخيانة، ولغتهم شُبهة تلقي بصاحبها في جحيم الاختطاف والتعذيب أو تقوده إلى القتل مباشرة. يفسر هذا لماذا كان الأمازيغ سبّاقين إلى الانخراط في الثورة الليبية التي انطلقت يوم 17 فبراير 2011، والتي بذلوا فيها تضحيات جسيمة، وأصبح لهم خلالها مئات الشهداء الذين يؤثثون بصورهم الساحات العمومية في مناطق زوارة ونفوسة.
أتاحت الثورة لأمازيغ ليبيا أن يتنفسوا الصعداء، وأن يقوموا بإعادة الاعتبار للغتهم ومظاهر هويتهم العريقة في الواجهات العمومية بمناطقهم، وفي أنشطتهم الثقافية التي انطلقت لأول مرة خارج نطاق الخوف واللاأمن بعد سقوط النظام، كما أدرجوا لغتهم في التعليم وأحدثوا قنوات إذاعية وقناة تلفزية أمازيغية، كما نجحوا في التنسيق مع إخوانهم المغاربة في تكوين المدرسين وفي منهجية التدريس والتأليف المدرسي، كل هذا قبل أن تستقر الأوضاع ويتم إرساء الدولة المستقلة بدستورها ومؤسساتها. واستطاعوا إلى جانب ذلك التمرّن بسرعة على أساليب التظاهر السلمي والمرافعة والمناظرة التي كانت منعدمة في ظل النظام البائد، وتمكنوا من حشد جماهيرهم في أكبر المظاهرات وسط طرابلس لبعث رسائل دالة إلى أعضاء المجلس الوطني الانتقالي آنذاك، كما استطاعوا دعوة جميع الأطراف السياسية والمدنية بمن فيهم القوميين والإخوان إلى "ملتقى الاستحقاق الدستوري لأمازيغ ليبيا" يوم 12 يناير 2013، لكي يفهم الجميع أن ليبيا الإقصاء والتهميش والعنصرية قد انتهت، وأن الوقت قد آن لبناء ليبيا الموحدة التي يجد فيها جميع أبنائها على قدم المساواة الحماية والعيش الكريم.
لم تكن هذه الجهود التي بذلها أمازيغ ليبيا نابعة إلا من إحساسهم باستحكام إيديولوجيا القذافي في أغلب النخب، فالاستبداد لا يزول بزوال الحاكم، بل تستمر آثاره لسنين طويلة في النفوس والأذهان، وكانت مخاوفهم مبرّرة وفي محلها، عندما اصطدموا في أول امتحان بالتصلب الإيديولوجي لأغلبية أعضاء المجلس الوطني الليبي الذين لم يتحلوا بالحكمة وبالحسّ الوطني الديمقراطي اللذين يتطلبهما المقام، ورفضوا تمتيع إخوانهم الأمازيغ بتمثيلية مشرّفة في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، كما رفضوا اعتماد آلية التوافق في وضع القانون الأسمى للبلاد، معتبرين أن على "الأقليات" أن تخضع لـ"صوت الأغلبية" العددية، هذه الأغلبية التي لا تعرف في قاموسها كلمات مثل التعددية والتنوع والاختلاف، والتي هي مرادفة عندها للمؤامرة والتقسيم.
نتيجة دكتاتورية الأغلبية العددية العمياء، التي لا تفهم أن الديمقراطية قيم قبل أن تكون عملية تصويت، هي أن أمازيغ ليبيا ـ ومعهم "الطوارق" و"التبو" ـ أعلنوا انسحابهم من المجلس الوطني الليبي ومقاطعتهم للهيئة التأسيسية، كما أعلنوا العصيان المدني واعتبروا كل ما سيصدر عن الهيئة التأسيسية غير ملزم لهم، وأصبحت ليبيا على فوهة بركان بعد أن كان باستطاعتها تخطي هذه المرحلة الصعبة بنجاح تام.
الدرس الذي ينبغي استخلاصه مما وقع في ليبيا وقبل ذلك في مصر، وقد يقع غدا في تونس، هو أن الديمقراطية التمثيلية وآلية التصويت لا تكون فعالة في الدول الخارجة من الاستبداد إلا بعد أن يحصل الترسيخ الديمقراطي للقيم الجوهرية، قيم الحرية والمساواة والعدل والتعاون والتشارك، وللأساس المشترك العام الوطني الذي يشمل الثوابت الديمقراطية المتوافق عليها مصونة ومحصّنة في الدستور، بحيث لا يمكن لأحد المسّ بها والاعتداء على حقوق غيره، ثم الاحتكام بعد ذلك إلى صناديق الاقتراع لفرز من يتولى تسيير الشأن العام، وبدون ذلك ستظل شرعية الصناديق موضوع منازعة من طرف شرعية الشارع ومكونات الشعب، لمدة قد تطول أو تقصر ، لتعود في النهاية ـ بعد ضياع وقت ثمين ـ إلى نقطة الانطلاق، لأنه لا يصحّ أبدا إلا الصحيح.