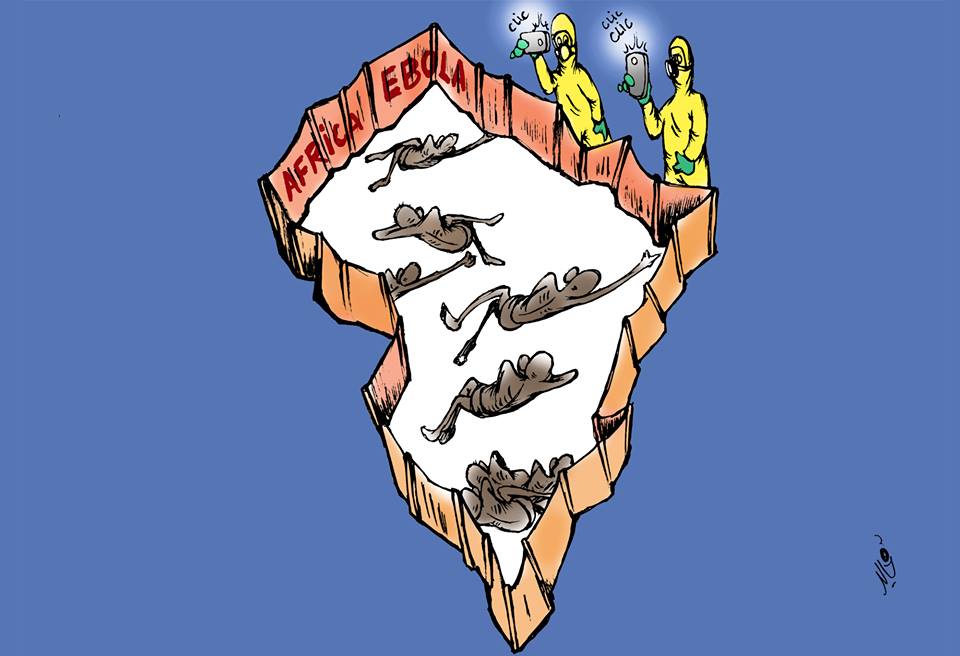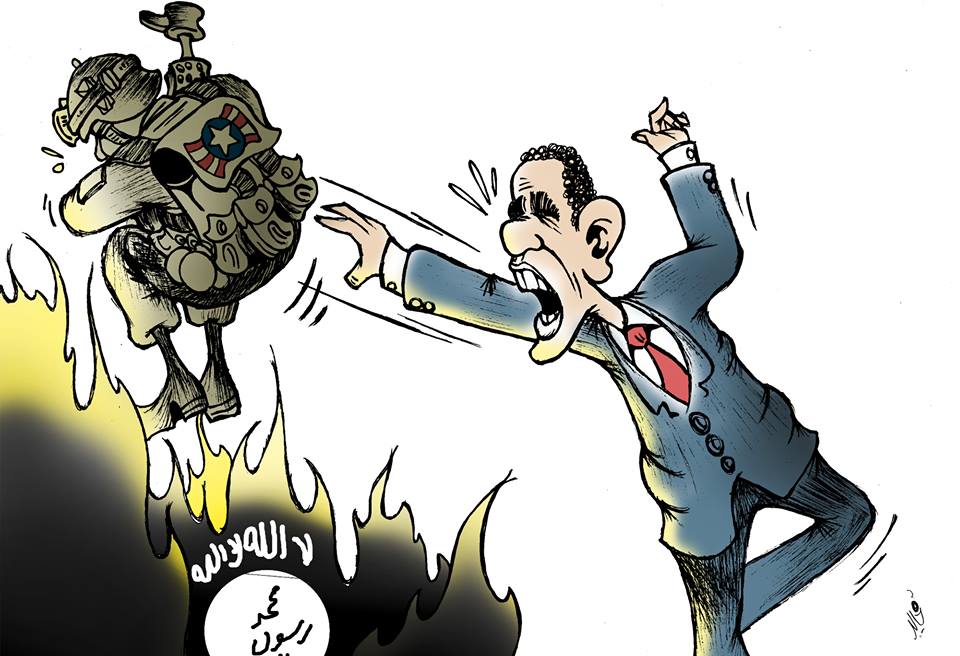عوائق إصلاح التعليم بالمغرب
تناوُل خطاب ملكي لموضوع التعليم جعل نسبة هامة من الفاعلين السياسيين والمدنيين يتطارحون قضايا التعليم لكن في حدود لا تسمح بإدراك عمق المشكل. وإنها لمعضلة حقيقية ألا تنتبه النخب إلى مشكلة ما أو لا تعطيها الأهمية التي تستحق، إلا عندما تكون موضوع خطابات أو تعليمات ملكية. وهي ما يدلّ على عقم نخبنا وضعف روح المبادرة عندها.
ثمة جملة عوائق ينبغي تعميق النقاش فيها إذا أردنا الخروج برؤية واضحة تمكن من حل مشاكل التعليم بشكل فعليّ:ّ
أولها وجود عطب وارتباك في مفهوم الوطنية المغربية ذاته، والذي صيغ على مقاس توجه انبنى في المرحلة الكولونيالية، واعتمد في الخطاب الوطني على مرجعيتين أجنبيتين هما: مرجعية النموذج اليعقوبي الفرنسي للدولة الوطنية من جهة، والمرجعية القومية العربية ـ الإسلامية التي جعلت المشرق مركزا ثقافيا وهوياتيا للمغرب، وهذا فوّت على المغرب فرصة أن يبني نموذجه الخاص بوصفه بلدا إفريقيا قبل كل شيء ومتوسطيا يحظى بموقع جغرافي يؤهله لأن يساهم في رصيد الإنسانية بنصيب أوفر. لقد كان أمرا ضروريا من أجل الوصول إلى بناء مدرسة وطنية أن نجعل محلّ التبعية للمركزين الفرنسي والمشرقي رؤية حضارية متوازنة تجعلنا نستفيد من مختلف التجارب الإيجابية دون أن نفقد بصمتنا الخاصة.
العامل الثاني الذي عرقل وجود شروط طبيعية لنظام تربوي وطني هو اعتبار التعليم منذ بداية مرحلة الاستقلال مجال تجاذب بين السلطة وتيارات سياسية وإيديولوجية مختلفة، وكذا اللوبيات الإدارية والمجتمعية الحليفة لهذا الطرف أو ذاك، وبما أن السلطة كانت دائما في وضعية الأقوى فقد فرضت على المنظومة التربوية نوعا من الرؤية الإيديولوجية التي جعلت الهاجس البيداغوجي الاستراتيجي ثانويا، مما أفضى إلى استعمال التعليم في تاكتيكات السلطة ولأغراضها الظرفية، وهو أسوأ ما يمكن أن يقع لنظام تربوي ما، لأنه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يبلغ أهدافا واضحة، ما دامت السلطة في بلد غير ديمقراطي لا يمكن أن تقر على نهج حاسم، لأنها تفتقر إلى استراتيجية واضحة وشمولية. لقد كانت السلطة مثلا خلال السبعينات والثلاثينات تعتقد جازمة بأن المعارضة التي تستهدفها منشأها التعليم ورجال ونساء التعليم، ولهذا سعت بإصرار إلى كسر شوكة المدرسة التي "تفرخ" ـ حسب منظور السلطة ـ جماعات من المتمردين، والحال أن المدرسة لم تعكس إلا ما يجري في المجتمع، لأنّ دينامية المدرسة تتطلب أن تكون مجالا لبلورة وصقل وعي نقدي لدى الأفراد الذين سيصبحون مواطنين، وليس إعادة إنتاج القيم السائدة في المجتمع والتي ليست كلها بالقيم الإيجابية التي تسمح بتطور المغرب.
العامل الثالث هو تأثر النظام التربوي بشكل كبير بالتصدّعات التي أصابت النسق السياسي والمؤسسات بالمغرب مما جعل درجة الفساد العظمى التي بلغها تسيير المؤسسات ينعكس بشكل كارثي على المؤسسات الوصية على التعليم، وهذا أدى إلى جعل البرامج والمشاريع تتحول إلى صيغ بلاغية وشعارات يتم تردادها من طرف الجميع دون أن يكون لها أثر مباشر على المستوى الإجرائي، وسادت موجة من "الببغائية" Psittacisme تمعن في ترداد ما ينبغي عمله حسب هذه المرجعية أو تلك، ولا يتحقق من ذلك كله إلا قدر ضئيل من المكاسب الإيجابية التي سرعان ما يتمّ الالتفاف عليها بسبب سوء التدبير المؤسساتي وشيوع ذهنية لا مبالية بمصير التعليم عموما.
العامل الرابع عدم وجود تراكمات إيجابية يتم الحفاظ عليها في بناء التجارب الناجحة، فمن المعتاد في المغرب أنّ كل وزير يأتي يبذل جهدا كبيرا في محو آثار من سبقه، مما يؤدي إلى ضياع التراكمات الإيجابية وعدم وجود استمرارية في اتجاه محدّد.
كما أن ثمة عامل آخر هو استنساخ التجارب الأجنبية بشكل آلي دون الاشتغال عليها ومطابقتها مع السياق الوطني ومع التراكمات السابقة، كما لا تعطى المدة الزمنية الكافية لتقييم التجارب المتبناة، حيث سرعان ما يتم استبدالها بغيرها بدون مبرر واضح، ينضاف إلى هذا انعدام الثقة في المختصين التربويين الوطنيين والإعلاء من شأن التجارب الأجنبية التي لها سياق تطور خاص ذي صلة ببنيات اجتماعية وأبحاث وقيم لا يتمّ استيعابها بما يكفي، حيث تصبح الاستفادة من تجارب الدول الأخرى مجرد استنساخ لها .
وإلى هذه العوامل يمكن إضافة عامل الإحباط العام الذي يعود إلى انسداد الآفاق وشيوع البطالة، وعدم ارتباط التعليم بسوق الشغل، وتراجع الثقة في المؤسسات وخاصة المؤسسة التربوية، لقد أصبح المجتمع نفسه يكرس منظورا ازدرائيا للمدرسة العمومية حيث يقدم أشخاصا على أنهم ناجحون في مجال المال والأعمال والرياضات والفن وغيرها بفضل تركهم للمدرسة، فأصبحت المدرسة تبدو كما لو أنها عائق أمام هذا النوع من النجاح الذي لا يحتاج إلى التمدرس، كما صارت تتخذ طابع المؤسسة التي "تفسد" الأفراد وتجعلهم لا يصلحون لشيء غير انتظار وظيفة الدولة وتحمل البطالة.