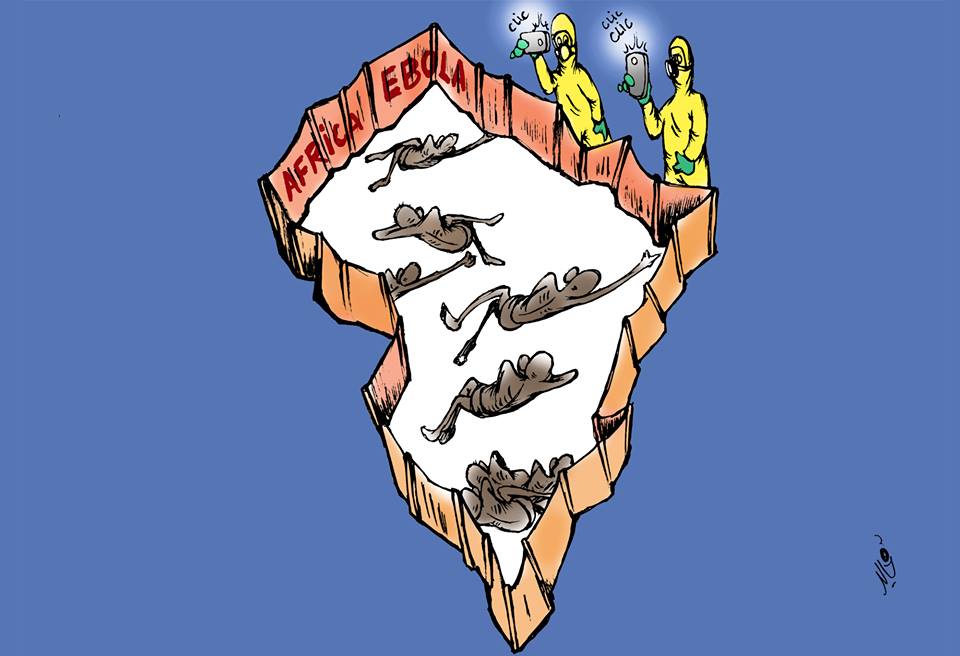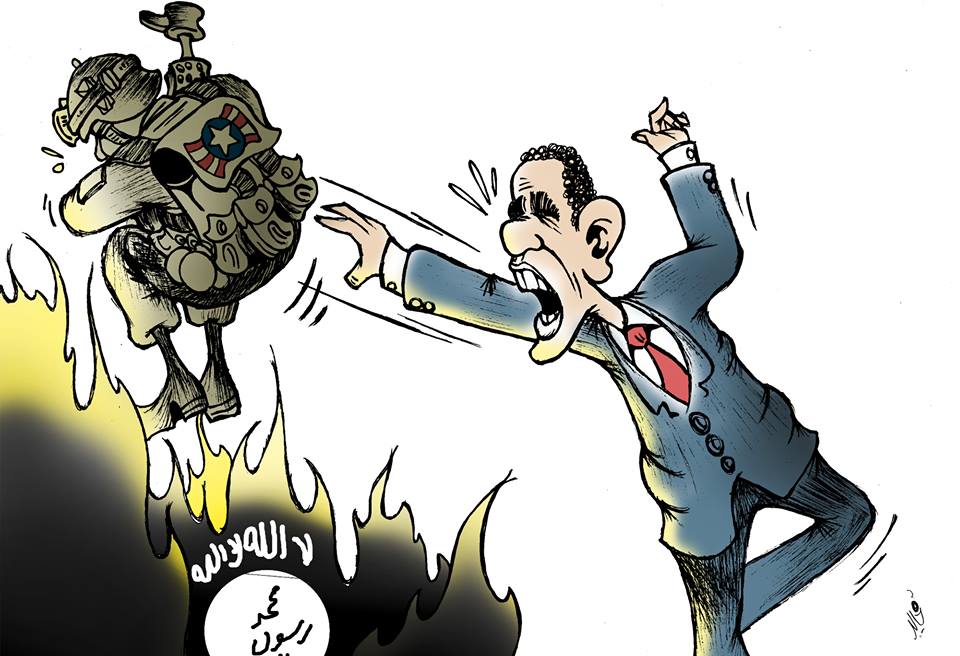أخطاء في النقاش حول معنى "التكفير"
اتخذ النقاش حول "التكفير" منعرجات انحرفت به عن القصد، وبدأ يفضي إلى منزلقات ليست في صالح المواطنين المغاربة سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين، ذلك أنه عوض أن تناقش القضايا والآراء كما يتم التعبير عنها يتمّ بدءا تحريفها تحريفا مغرضا ثم مناقشتها بعد ذلك، ما خلق الكثير من سوء التفاهم وبعُد بالناس عن بيت القصيد.
يرى المحافظون بأنّ العلمانيين هم البادئون بالإساءة في مناقشة "النصوص القطعية الصريحة" والتي هي من "المعلوم من الدين بالضرورة"، مما يبرّر حسب هؤلاء "تكفيرهم" الذي قد يترتب عنه قتلهم وإيذاؤهم، ما يعني ضرورة أن يصمتوا لكي ينجوا بأنفسم من "التكفير" وعواقبه.
وهذا الرأي خاطئ من وجهين: أولا لأنه رأي فاشستي يقوم على الترهيب والتهديد وحجّة القوة وليس على قوة الحجة، ثانيا لأنه يساوى بين من يدعو إلى مناقشة قضايا اجتماعية وحقوقية لها صلة بنصوص دينية، ومن يُكفر أو يهدّد بالقتل ويشيع الكراهية في المجتمع. فالذي يطرح قضية للمناقشة ويطالب بالاجتهاد في الدين (ما دام العقل الإسلامي قد اجتهد من قبل في نصوص كثيرة "قطعية وصريحة") إما أن يكون على صواب وفي هذه الحالة فهو يسدي للمجتمع خدمة جليلة، وإما أن يكون على خطأ فيبيّن الناسُ خطأه ويردّوا عليه ويعرّفوا عبر الحوار والمناظرة بحقيقة الموضوع، ولكن لا يجوز ولا يُتصور بحال من الأحوال أن يكون الردّ على الفكرة أو المقترح أو المطلب هو الكراهية والعنف اللفظي أو المادي.
فإذا كانت المناقشة والمطالبة بالحقوق لا تقتل الإسلاميين والمحافظين والسلفيين والإخوان، فإن "التكفير" يقتل العلمانيين ويمسّ بسلامتهم الجسدية، بدليل أن هناك من قتل بذلك وسلب حقه في الحياة بسبب آراء فكرية أو مواقف سياسية، بل إنّ هذا أدّى إلى إسقاط حكومة بكاملها في تونس ووضع دستور يجرّم "التكفير".
إنّ من يطالب بالإنصاف ورفع الظلم، لا يمكن أن يتساوى مع من يقول له: هذا هو الدين فاسكت وإلا قتلتك ! فلا وجه للمقارنة بين الفعلين، الأول حق لكل واحد، أن يناقش ويطالب بمزيد من الحقوق التي تصون كرامته، بينما الثاني يتحدث بنفَس انتقامي وبروح إجرامية يهدف من ورائها إلى إسكات الخصم وإرهابه من أجل الحفاظ على مصالح معينة أو وضعية ما، أو بسبب عدم القدرة على المناقشة والإقناع.
إن الفكرة التي ترى أن على الدولة أن تقوم بمعاقبة من يطالب بمراجعة أحكام الدين التي ينجم عن تطبيقها ظلم أو هدر للكرامة بعد تغيّر الواقع تغيّرا جذريا، وتعتبر إحجام الدولة عن الانتقام من هؤلاء مبررا لأن تقوم أطراف أخرى في المجتمع بذلك ولو عن طريق الإكراه والعنف والتصفية الجسدية، هي فكرة لا تتلاءم مع الدولة الحديثة، دولة القانون، بل هي من البقايا السلبية للماضي.
اعتبر بعض المحافظين بأن العلمانيين يطالبون بـ"فصل الدين عن الدولة" مما يجعلهم غير ذوي أهلية لمناقشة أمور الدين التي لها مختصوها وهم الفقهاء، غير أن هؤلاء غاب عن فهمهم بأن العلمانيين لا يناقشون الدين بل أشكال استعمالاته وتوظيفاته السياسية في الدولة والمجال العام، فإذا أراد المحافظون أو السلطة ألا يتكلم العلمانيون فيما له علاقة بالدين فليس عليهم إلا التوقف عن استعماله في الإضرار بحقوق الناس وتبرير الاستبداد والعنف واللامساواة وكراهية الآخر، وقمع الحريات كما هي متعارف عليها في العالم الديمقراطي كله. فمن اكتوى بممارسة ما وطاله منها ضرر لا بدّ أن يناقشها، وليس لأحد أن يقول إن ذلك من عند الله ما دام البشر هم المكلفون بالتدبير والتسيير، وهم الخطائون المعتدون على بعضهم البعض.
إن من يريد صيانة الدين من الانتهاك لا يقحمه في الصراعات السياسية وفي المهاترات الإيديولوجية، بل يعتبره اختيارا شخصيا حرا لا إكراه فيه، وهذا ما ينصّ عليه الدين نفسه.
يتحدث المحافظون ويسندون أفكارهم إلى "الشعب" معتبرين أن "الشعب" هو من يريد هذه المواقف المتطرفة ويطمئن إليها لأنه "شعب" محافظ ومتدين، وهو ادعاء يكذبه الواقع الذي يؤكد نفور الناس من الفتنة ومن العنف ومواقف الغلو والتطرف، كما يؤكد بأن الإسلاميين الذين يحتكرون الكلام السياسي باسم الدين لم يحصلوا في الانتخابات رغم نصرة السلفيين والعدليين لهم إلا على ما يقرب من خمسة في المائة من أصوات المغاربة الذين في سنّ التصويت (والذين هم 22 مليون). وحتى إن صحّ أن "الشعب" على هذه الشاكلة المنحرفة فإن الحلّ ليس في مداهنته وتكريس الجهل والتخلف بل في تأهيله وتربيته وتوعيته على القيم الإنسانية النبيلة.
يتماهى المتطرفون مع الآيات القرآنية التي تتوعد "من يجادل في آيات الله" أو لا يطبقها، فيجعلون منها آيات دالة على تبرير "التكفير" والعنف ضدّ مخالفيهم في الرأي، والحقيقة أن ذلك وعيد إلهي بسوء المصير في الآخرة وليس تفويضا لأحد بأن يقتصّ من الناس في الدنيا نيابة عن الله.
ختاما نرى بأنّ هذا النقاش كله باطل من أساسه لأن "التكفير" غير ذي موضوع، ما دام مفهوم "الكافر" لا أساس له في قوانين الدولة ولا وجود له في معجمها الذي تتعامل به مع المواطنين، فهي تمنحهم بطائق الجنسية دون أن تسأل عن معتقدهم، كما أنها تسمح لهم بتولي المناصب والوظائف العمومية دون أن تشترط عليهم الإيمان بدين معين، ويتمّ هذا في إطار مفهوم المواطنة، فما دامت المواطنة تساوي بين الجميع بغض النظر عن المعتقد فإن ما اصطلح عليه بـ"الكافر" لم يعد له وجود، بل يتحدث الناس اليوم عن "المؤمن وغير المؤمن"، وهما متساويان أمام القانون، وعليهما احترام بعضهما البعض، فلا يستعمل المؤمن عقيدته لإلحاق الظلم بمواطنه غير المؤمن، ولا يعمد هذا الأخير إلى تسفيه معتقد مواطنه المؤمن أو الإساءة إلى مقدساته الدينية، أما شئون المجتمع، فيتم تدبيرها بقوانين محايدة تضمن العدل والمساواة والحرية لهما معا. وفي حالة ما إذا ما اختلفا على ذلك فليس أمامهما من خيار غير الحوار العقلاني والنقاش الموضوعي. وإلى حين أن يظهر نموذج آخر للدولة يتجاوز الدولة الحديثة وينسخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنة والمساواة، فليس علينا إلا بذل الجهد من أجل إقامة العدل بين الناس كما هو متعارف عليه في زماننا هذا.