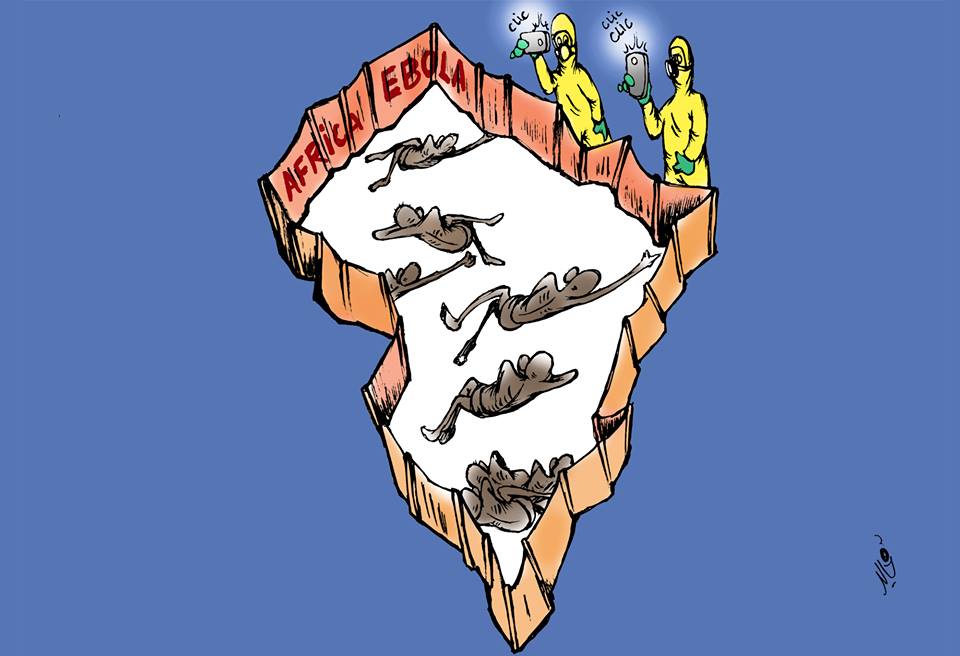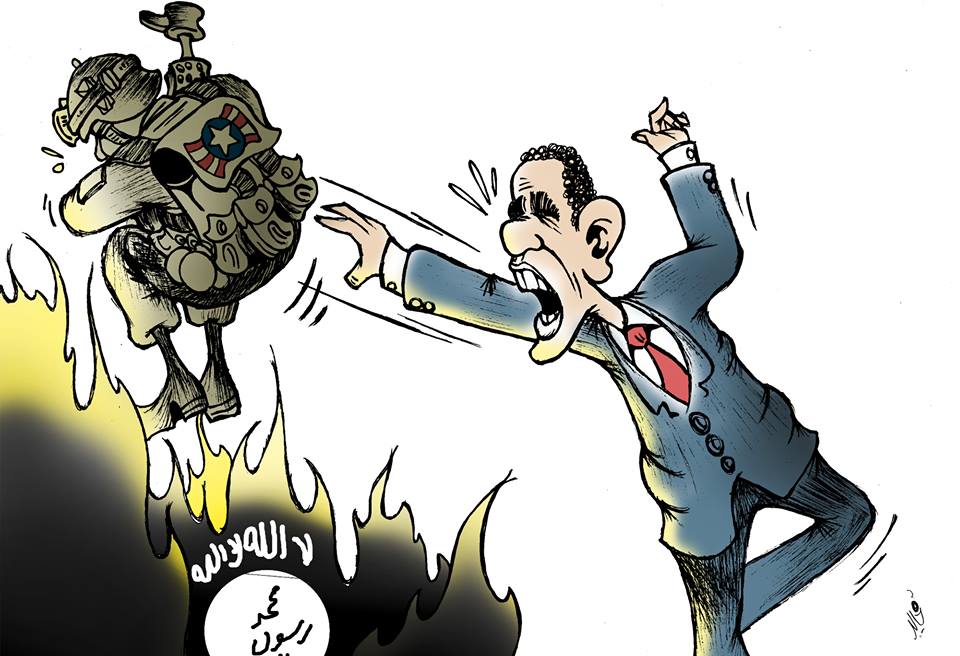الطوزي يكشف آليات إحتكار الدولة المغربية للدين لإنتاج "إسلام مغربي"

زنقة 20
“هل يقتضي الشأن الديني سياسة عمومية أم لا؟”. بهذا السؤال افتتح، عشية الجمعة الفائتة بالمكتبة الوسائطية بالبيضاء، الباحث السياسي والاجتماعي المعروف محمد الطوزي محاضرته الموسومة بـ”الحقل الديني بالمغرب في ظل الليبرالية الجديدة”. وهي عبارة عن دراسة صدرت له بالفرنسية قبل 3 أشهر ضمن مؤلف جماعي بفرنسا، وتتناول بالدرس والتحليل سياسة الدولة المخزنية فيما أسماه بـ”برقرطة” المجال الديني والتحكم في آليات إنتاجه.
السؤال الذي ابتـدر به الطوزي حديثه رام من خلاله “الاقتراب من الفرضيات الضمنية للمصلحين وإبراز الخلفيات الذهنية لهذا الإصلاح”. وقد استطاع فعلا أن ينفذ إلى عقل الدولة ويسلط الضوء على كيفية تعاطيها مع الشأن الديني منذ 2004، أي بعد أحداث 16 ماي الإرهابية بعام واحد، مع تقديمه إضاءة تاريخية لتدبير الدولة للدين قديما، قبل إنشاء الدولة الحديثة، وحديثا بعد الاستقلال، وإبان الثورة الإيرانية، عندما أنشأ الحسن الثاني المجلس العلمي الأعلى، وصار السؤال الديني هاجسا حاضرا في كثير من خطبه.
ويسجل الطوزي أن الاهتمام بـ”دولنة” (Etatisation) الدين في المغرب لم يبدأ بشكل تنظيمي وشامل إلا عام 2004، مع شيوع الحديث عن “إعادة هيكلة الحقل الديني” و”الأمن الروحي” و”القيّم الديني”، وهي مفاهيم من إنتاج واستعمال الدولة، (تم تصديرها إلى الصحافة والإعلام)، وتعبر بشكل مباشر عن سياستها المعتمدة في الحقل الديني، والتي تحمل كل مقومات السياسة العمومية، وتخترق قضية العقيدة، وتهدف في العمق إلى إنتاج “إسلام مغربي”. ورغم ما يحف هذا المفهوم من ضبابية، وجذوره الكولونيالية من حيث الاستعمال، فهو يلخص سياسة الدولة الدينية الجديدة.
واعتبر الطوزي أن “فتوى المصالح المرسلة” الصادرة عن المجلس الأعلى عام 2004 هي بمثابة النص المؤسس لعملية “برقرطة” العقيدة نفسها، وإنتاج ما وصفه بـ”سياسة مدنية دينية”، وهي تعطي بحسبه “تفويضا عاما لأمير المؤمنين” مقرونا بتحقيق المصلحة العامة. ومن خلال هذا التفويض العام يرجع أمير المومنين إلى هؤلاء العلماء أنفسهم كتقنيين لإنتاج ما سماه الطوزي بـ”التخريجة الفقهية”. ويرى المحاضر هذا الاحتكار للدين يعمل على “تحييد” العلماء وجعلهم مجرد تكنوقراط يعملون وفق الطلب وتنتفي عندهم أي مبادرة.
وفي ذات السياق، لاحظ الطوزي أن أغلب موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هم مهندسون وإعلاميون. وبذلك يكون المجلس الأعلى عبارة عن مؤسسة تقنية، فيما أوكلت الدولة الوظيفة الإيديولوجية إلى الرابطة المحمدية للعلماء المشتغلة بـ”فقه السياق” لا فقه المقاصد، من أجل إنتاج منظومات إيديولوجية جديدة. وهو ما يحاصر جميع الإنتاجات الدينية التي تتم على الهامش ويقلص من تأثير الجماعات الإسلامية الأخرى.
وتحدث الطوزي عن أثر الليبرالية الجديدة في إنتاج مساطر ذات بعد أحادي، واحتكار إنتاج الدين من موقع سلطوي، وقد تمت دسترة هذا الاحتكار نفسه عبر خلق نوع من الفصل العمودي بين الدين والدولة. أي إبعاد الدين عن السياسة على مستوى القاعدة (الأحزاب) وليس على مستوى القمة. ولم يفت الباحث أن يشير كيف أن وزارة تقليدية، مثل وزارة الأوقاف، صارت تدبر الشزن الديني بتقنيات البيروقراطية الجديدة، التي أنتجتها الليبرالية الجديدة وصدرتها المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك الدولي.
ومن تجليات هذه السياسة الجديدة حسب الطوزي تدبير الدولة للمساجد (الخاصة والعامة)، وبرقرطة تدبير التدين من خلال كتيبات ومنشورات وخطب وقرارات سياسية وإطلاق وصفة خطبة الجمعة وتحديد مواصفات الإمام النموذجي، وربط مؤسسات الأحباس بالوظيفة العمومية، وإعادة ضبط مؤسسات الشرط، واعتماد قاموس جديد من قبيل “الأجندة” و”الإنتاجية” و”الحكامة”… ويبقى ثمة سؤال ملح، ما هي المخلفات اليومية لهذه السياسة الدينية؟
ويحيل الطوزي في معرض رده على أول وقفة احتجاجية للأئمة في إطار حركة اجتماعية مؤطرة. وهنا يوضح أن مفهوم القيم الديني صار اليوم جامعا للمؤذن والإمام وإمام الجمعة والمشرف على فتح وإقفال المسجد والحزّاب وغيرهم. هؤلاء لم يكونوا يرتبطون من قبل بعقود عمل، واليوم صارت تربطهم بالدولة علاقة مادية علي اعتبار أنهم مهنيين (الراتب الشهري والتغطية الصحية…)، وقد بلغ عددهم 42 ألفا والعدد في ازدياد مما سيطرح على الدولة في المستقبل أعباء حقيقية وتحديات أكبر في تدبير هذا المجال.