الـرأس والـجـسـد
تحدثت الصحافة المغربية عن نشوب خلاف حاد داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بمناسبة عقد المؤتمر الإقليمي للحزب في فاس، بين مجموعة الأعيان ومجموعة "الفعاليات اليسارية". المجموعة الأولى تتهم المجموعة الثانية بتجاهل دور الأعيان ومجهوداتهم الكبيرة لصالح الحزب، خلال إعداد مادة الشريط الذي عُرض في افتتاح المؤتمر الإقليمي، والذي تناول مسار الحزب. الأعيان يعتبرون أن "اليساريين" يريدون احتكار الحديث باسم الحزب والانفراد بتقرير شؤونه والانشغال بتأمين مستقبلهم وحدهم داخله وممارسة نوع من التعالي حيال الأعيان، واعتبار هؤلاء مجرد خزان لتأمين موارد الحزب من الأموال والمقاعد الانتخابية. فريق الأعيان يعتبر، كذلك، أن الحزبيين، الوافدين من تيارات يسارية، يحولون بينه وبين ممارسة عدد من حقوق العضوية الحزبية وبينه وبين التمتع بعدد من فوائد الانتماء الحزبي.
فهل انتهى عهد التساكن بين مجموعتين قادمتين من موطنين مختلفين ومن بيئتين متباعدتين؟ وما هي الصيغ التي سيتم اللجوء إليها، مستقبلاً، لتأسيس قاعدة تفاهم صلبة بين المجموعتين ولتنظيم العلاقات بينهما؟
إن مثل هذا الخلاف، الذي طفا على سطح المؤتمر الإقليمي في فاس، ليس إلا نتيجة منطقية للظروف والملابسات التي تحكمت في مسار تكوين الحزب والتي جعلت مؤسسيه يختارون طريقة معينة للتكيف مع مقتضيات الإكراه الانتخابي، ويبتعدون عن الصيغة الأصلية التي كانوا يريدون أن يظهر عليها الحزب في البداية.
قام تأسيس الحزب، في نظرنا، على ثلاث أفكار أساسية :
الأولى هي ضرورة مواجهة الخطر الأصولي. وفي هذا الإطار، يجب الاعتراف، فعلاً، بأن الأصولية تمثل خطرًا على الديمقراطية؛ ولكن ذلك لا يعني حرمان الأصوليين من ممارسة حقوقهم السياسية. عندما ينطلق فاعل سياسي من أن الحلول التي يقترحها لمعالجة مشاكل المجموعة الوطنية هي كلام الله، وأن كلام الله أكبر من الديمقراطية، وأن هذه الأخيرة يجب أن تُمَارس في الحدود التي لا تتعارض فيها مع كلام الله، وأن كل ما يصدر عن الله لا يمكن أن يكون موضوع جدل برلماني، وأن كلام البشر وحده هو الذي يكون محط نقاش وأخذ ورد في رحاب المؤسسات المنتخبة، فإن الفاعل السياسي يحصن برنامجه ويسمو به فوق النقد، ويريد أن يميزه عن برامج الآخرين وأن يفرغ الآلية الديمقراطية من معناها وماهيتها. إن الفاعل السياسي عندما يُضفي على حلوله طابع القداسة، عن طريق اعتبارها كلاما لله سبحانه وتعالى، إنما يحدد، في العادة، كلام الله انطلاقاً من منهجية مضى عليها أكثر من 12 قرناً، ولكنه لا يستطيع تعميم تطبيق تلك المنهجية، ويتجاهل حق الآخرين في استخراج ما يعتبرونه كلام الله، أيضاً، بالاعتماد على منهجية أخرى قابلة للتعميم. لقد قيل، مثلاً، إن كلام الله يفرض ألا تتزوج المرأة بدون ولي، ويقضي بقتل كل مسلم يغير ديانته وبارتداء الحجاب وبمنع حزب ماركسي من حق الوجود وبتحريم الأبناك وشركات التأمين وبمنع عدد من أنواع الفنون الجميلة، كنحت التماثيل، وبعض الرياضات النسوية وبالانتقاص من حقوق المواطنين غير المسلمين واعتبارهم جالية في بلدهم..إلخ.
والفكرة الثانية هي ضرورة صنع بديل سياسي يحل محل نخب متهالكة وفاقدة للمصداقية ولروح المبادرة والاجتهاد، وغارقة في الدفاع عن مصالح أفرادها عوض الدفاع عن مصالح الشعب، وجانحة عن أصول التدبير الديمقراطي الداخلي، ورافضة لتداول النخب، ومتحررة من التزام الوفاء بالعهود والتعاقدات، وغائبة عن ساحة الفعل، وقليلة الارتباط بالواقع. التيارات الإسلامية تطور بناءها التنظيمي الداخلي وتحشد الأنصار وترتبط بالقواعد الشعبية وتنصت لنبض الشارع وتربي أعضاءها على قيم التضامن والتفاني في خدمة المشروع الجماعي رغم الحمولة المحافظة والماضوية لعدد من شعاراته. والبلاد في حاجة إلى قوة تقدمية خلاقة ومبدعة ومقدامة لمواجهة الاكتساح الأصولي للانتخابات ولحمل راية الدفاع عن الحداثة والعقل والإنسان ولاستنفار القوى الشبابية الحية وتعبئة الطاقات النيرة للمجتمع وتحقيق تمثيل وازن في المؤسسات بقوة الفكرة ونقاء السريرة وحيوية الفعل وعمق الاجتهاد، وبدون لجوء إلى التزوير أو الغش أو مخالفة القانون أو شراء الذمم.
كان هناك تقدير قوامه أن استمرار وضع الساحة السياسية على ما هو عليه، من تصاعد أصولي وعجز وتراجع للأحزاب التاريخية، سيؤدي إلى وضع المؤسسات تحت رحمة قوى محافظة ورجعية وضيقة الأفق، مما قد يخلق مشاكل للبلاد مع محيطها، ويعزلها عن إيقاع العصر، ويعود بها إلى الوراء، ويمس بدورها التاريخي كملتقى للحضارات وكرمز للتسامح والتنوع والحوار الثقافي وكقبلة للزوار، وينتج نوعاُ جديداً من الاستبداد، ويعمق التخلف والارتداد، وينشر الجهل والخرافة.
أما الفكرة الثالثة فهي ضرورة دعم "الأوراش الكبرى" التي تمثل التشخيص الأبرز لمشروع تنموي شامل يقوده "العهد الجديد"، ويعد بنقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة، ويقدم الحلول"الثورية" لكل معضلات التخلف والجمود، ويصالح أبناء المغرب مع بعضهم البعض، ويطوي صفحة الانتهاكات المقترفة في الماضي، ويوفر بنية تحتية تُنجز بفاعلية وسرعة، ويقضي على الفقر والتهميش من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويحقق ثورة اجتماعية بواسطة مدونة الأسرة، ويعيد الاعتبار إلى التعدد اللغوي والثقافي المغربي، ويعيد هيكلة المجال من خلال المفهوم الجديد للسلطة والجهوية المتقدمة وخطة الحكم الذاتي في الصحراء. هذا المشروع يحتاج إلى هياكل ونخب سياسية قادرة على الانخراط فيه واستبطان فلسفته والدفع به إلى الأمام والتجاوب مع منطلقاته ومواكبة سرعته واستيعاب أبعاده. وعليه، جرى التفكير في إيكال أمر بناء وقيادة القوة الجديدة إلى مجموعة من الوجوه المعروفة بخبرتها وكفاءتها التدبيرية، أو التي سبق أن خاضت معارك داخل أحزابها من أجل التحديث والتطوير والتخليق، أو التي أبانت عن اقتدار في مخاطبة الأجيال الجديدة من المغاربة، أو التي أثارت الانتباه من خلال مشاريعها ومبادراتها على صعيد المجتمع المدني أو انتجت أفكارًا نيرة. لكن، من الناحية العملية، تعذر استقطاب أكثر الأسماء التي تمت المراهنة عليها، وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية الجزئية (17 و19 شتنبر 2008) صعوبة توصل مثل هذه الوجوه إلى انتزاع العدد المطلوب من المقاعد في بيئة انتخابية تتحكم فيها المقاطعة الواسعة واستعمال المال والدين والشبكات الزبونية والولاءات الشخصية؛ فتَمَّ الاستنجاد، بعد ذلك، بأعيان الانتخابات لإنقاذ مغامرة تأسيس الحزب الجديد، وظهر هذا الأخير في صورة مخالفة لما جرى التخطيط له في السابق. وقيل إن لجنة لفحص العضوية منعت بعض الأسماء سيئة السمعة من الالتحاق بالحزب، ولكن ظاهرة الأعيان، في عمومها، قامت على معادلة سياسية لا تخفى على أحد، وليس من السهل التسليم بأخلاقيتها، فقد تصرف الأعيان، دائمًا، على أساس أن التزامهم بالولاء المطلق للنظام ومساندة كل مبادراته وخططه وقبول خدمته بدون تحفظ، يخول لهم الحق في استعمال جميع الوسائل لانتزاع المقعد والإفادة من علاقات الريع والمحسوبية وتبادل الخدمات الشخصية.
وهكذا اعتمد حزب الأصالة والمعاصرة بنية مركبة، تضم مجموعة الأعيان، من جهة، ومجموعة الأطر اليسارية، من جهة أخرى. اليساريون السابقون يريدون أن يكونوا بمثابة "رأس" الحزب ومصدر التفكير والتقرير والتواصل الوطني، وأن يكون الأعيان بمثابة بقية الجسد. اليساريون يتحدثون عن التجديد والحكامة والحداثة ودولة القانون والقطيعة مع الماضي، والأعيان يواصلون مسيرة الماضي بكل تداعياتها ومضاعفاتها على السياسة والاقتصاد والاجتماع. يساريو الأصالة والمعاصرة يزعمون المساهمة في بناء مغرب جديد، والأعيان يوفرون كل شروط استمرار المغرب القديم. كل من المجموعتين تباشر تعاملاً تاكتيكيًا مع المجموعة الأخرى، وما حدث في مؤتمر فاس يبين أن مجموعة الأعيان ترفض الاكتفاء بلعب الأدوار التي تحددها لها المجموعة الأخرى.
ليس هذا هو وجه التناقض الوحيد القائم في تجربة الحزب، فرغم اعترافنا بأن الأصولية تشكل خطرًا على الديمقراطية والتقدم، وبأن نخب الأحزاب التاريخية فقدت، عمومًا، مصداقيتها وفعاليتها وتأثيرها، وبأن ذلك قد يكون كافيًا لدفع البعض إلى الانخراط في الحزب بحسن نية، فإن هناك جملة من الأسئلة الجوهرية التي تطرح نفسها : هل من المستساغ، ديمقراطيًا، أن تتم مبادرة صنع "البديل" من أعلى ومن جهات يُفترض فيها الحياد؟ وهل الدفاع عن المشروع الحداثي يتطلب مواجهة أصولية الحركات الإسلامية وحدها ومهادنة أصولية الدولة؟ وهل هذه الأصولية الثانية، بما تنطوي عليه من وصاية وطقوس قاسية وخطاب رسمي يواصل إقامة ازدواجية بين البيعة والدستور..إلخ، لا تشكل، هي الآخرى، خطرًا على الديمقراطية؟ وهل من الجائز، ديمقراطيًا، أن يوجد هناك، باسم الحاجة إلى مشروع تنموي، برنامج جاهز وقار للدولة لا يتأثر بتغير الخرائط الانتخابية ولا يضعه المنتخبون، ويُطلب من كل الفاعلين أن يتنافسوا في حسن تدبيره وتطبيقه؟ هل السياسة هي فقط حسن التدبير أم إنها، قبل ذلك، فن رسم الاختيارات والقرارات والتوجهات التي يستند إليها هذا التدبير نفسه؟ وهل من المنطقي أن يدعي حزب، في لحظات ظهوره الأولى، أنه لا يصنف في خانة اليمين ولا في خانة اليسار بل يستند، في قاعدته الفكرية، إلى وثائق صادرة تحت رعاية مؤسسات عمومية (تقرير الخمسينية- توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة)؟ هل يمكن أن يحظى حزب بالامتيازات التي مُنحت لحزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات 2009، والتي ندد بمنحها مسؤولون حكوميون حاليون غير إسلاميين، ولا يجري أي تحقيق وطني في الأمر، ولا يثور الحزب المستفيد ضد ذلك، ثم يقول، بعدها، إنه مستقل عن جهاز الدولة وإنه ليس "حزباً للدولة"؟.





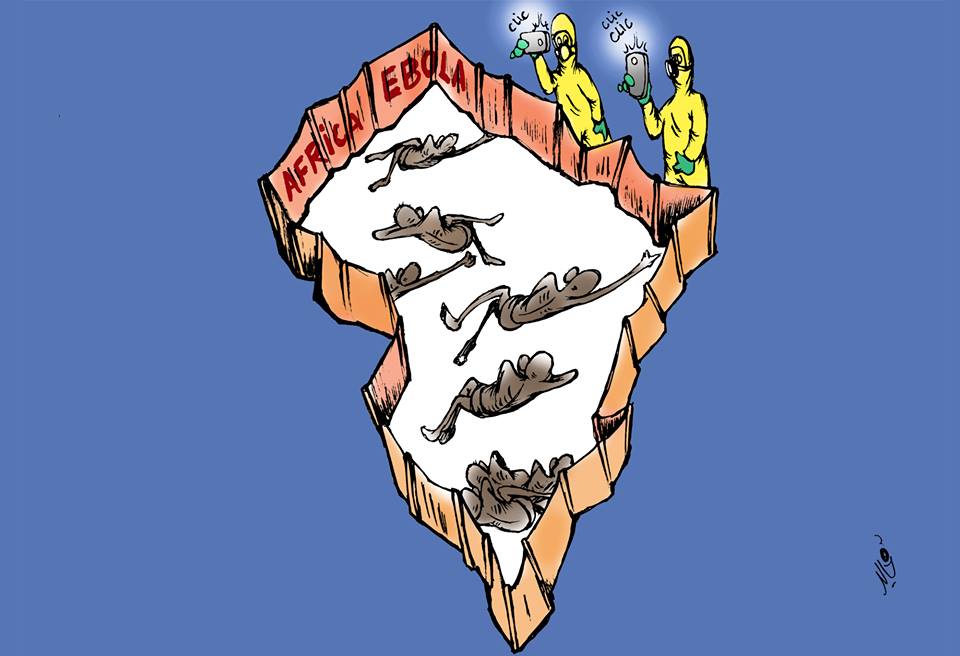



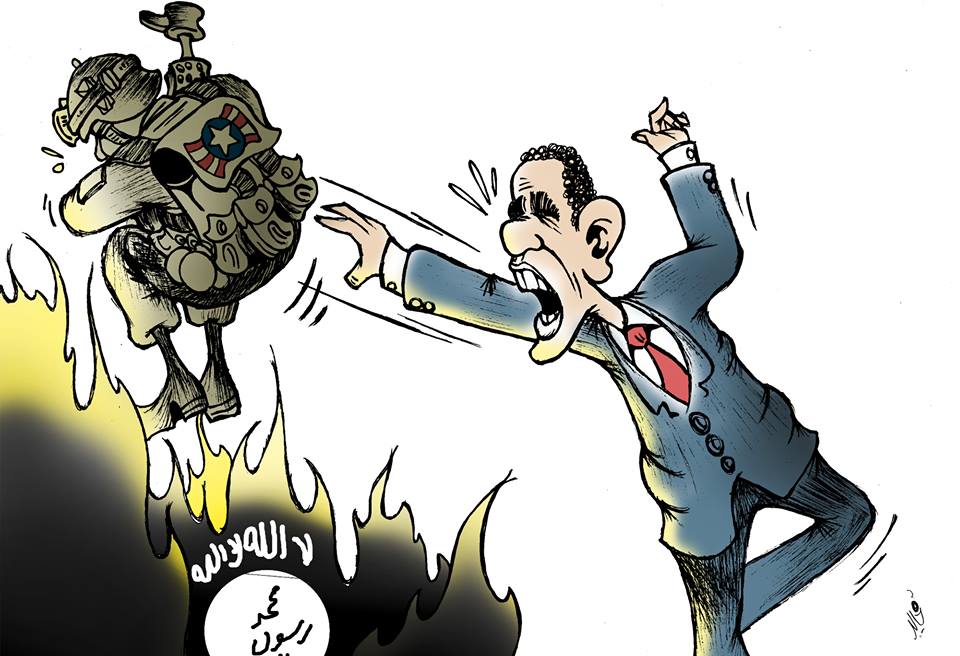



أتفق تماما مع الفكرة العامة لمقال الأستاذ الساسي، لكن أختلف معه في نقطتين: -الأولى: أن الإسلام السياسي (أو ما يفضل الكاتب تسميته بالأصولية) تشكل خطرا على الديمقراطية، رغم وجود أحزاب و حركات إسلامية تتبنى بشكل كامل مقتضيات الديمقراطية. إن هذا الإتهام السياسي الذي يلقيه ذ. الساسي على حركات الإسلام السياسي هو نوع من التكفير، و بالتالي دعوة إلى تطبيق الحدّ على هذه الحركات الإسلامية الكافرة بالديمقراطية. هل يُتهمّ الحزب المسيحي في ألمانيا بأنه سيتقل الدين المسيحي لأنه ينسب نفسه لهذا الدين؟ لماذا لا يثار موقف الحركات اليسارية من الديمقراطية رغم أن نموذجها الأصلي يقوم و قام في تجارب عدّة على فكرة الحزب الواحد التي تتعارض مع التعددية التي تعتبر شرطا ضروريا للديمقراطية؟ -الثانية: المساواة بين أصولية الدولة و أصولية الحركات الإسلامية، لأن هذا القياس فاسد بسب الفوارق بين النموذجين. فالدولة تستغل الدين من أجل إضفاء المشروعية على سلطتها و تقصي الدين من أي مجال آخر، عكس الحركة الإسلامية التي تسعى إلى نموذج يطبق الإسلام في مختلف المجالات. لو صَحَّت المساواة بين النموذجين لما توجست الدولة من شعبية الحركة الإسلامية و اندحار شعبيتها ولجأت إلى تأسيس حزب الأصالة و المعاصرة لمواجهة الإسلاميين.