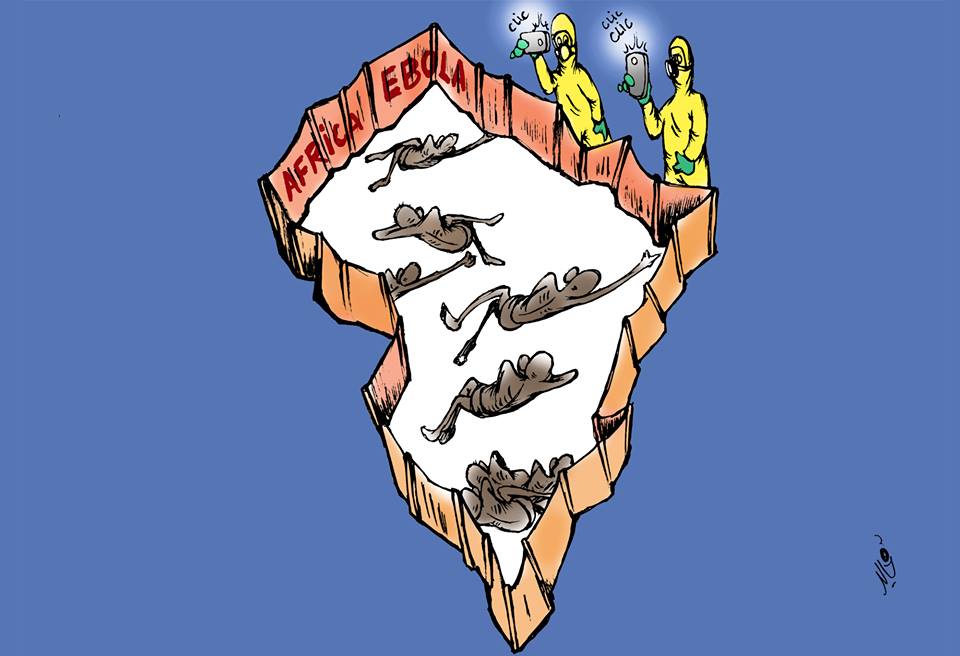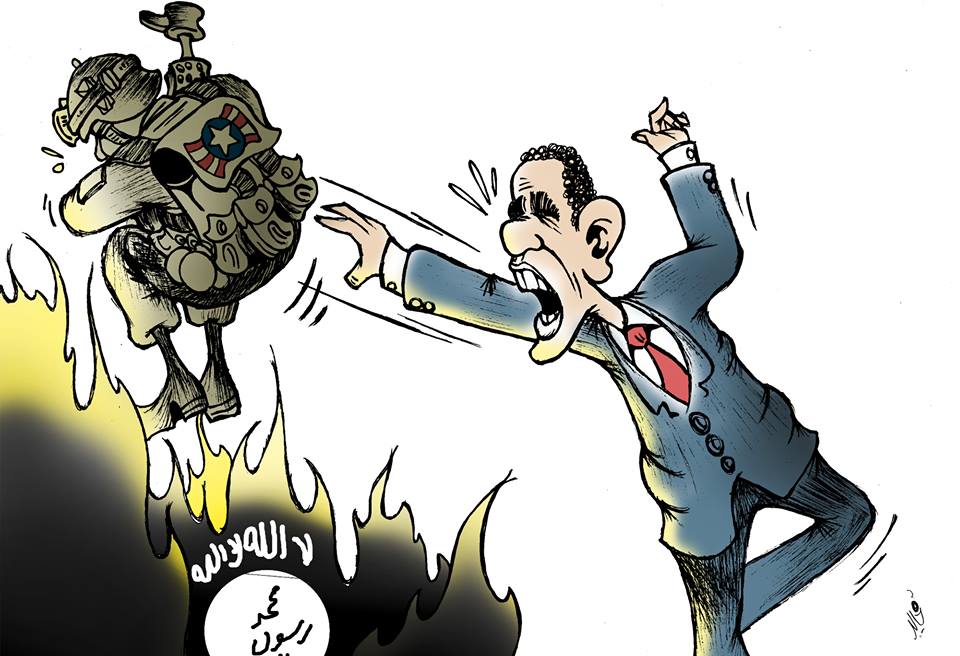عودة إلى تجربة التناوب في المغرب
شكلت الشحنة المعنوية التي ضخها حدث تنصيب حكومة التناوب التوافقي في النفوس عام 1998، صمام أمان لشرائح واسعة من المجتمع المغربي، لأنها رأت في الحدث إمكانية سياسية لفتح أبواب البلاد على مصراعيها أمام مسيرة البناء الديمقراطي والإصلاح المؤسساتي والانتعاش الاقتصادي . وهذا الشعور غذته بكيفية ملموسة ،موجة الحماس التي تدفقت بقوة في كل الاتجاهات، وتجاوب معها المجتمع من منطلق أن تلك المرحلة الوليدة كانت ستؤسس لقطيعة فعلية مع أصناف وأنماط مرفوضة ومبتذلة من الممارسة السياسية التي زجت بالمغرب في متاهة مظلمة من إهدار الفرص، مما حال دون اللحاق بركب التقدم والتنمية المتوازنة. كما أن هذا الشعور كرسته بشكل نسبي ،وسائل الإعلام المغربية والدولية التي باركت تجربة التناوب التوافقي، واعتبرتها إجراءا عمليا لإنقاذ البلاد من مأساة "السكتة القلبية"، التي كان الملك الراحل الحسن الثاني قد استعملها في قاموسه، ليختزل ويكثف الوضع المزمن الذي وصلت إليه البلاد وهو العارف آنذاك بخبايا الأمور.
إن أي مقارنة لن تكون لها فاعلية كبرى، إذا لم تضع حدث التناوب التوافقي في السياق النفسي العام، وإذا لم تعمد إلى عقد مقارنة بين خطابين سياسيين طبعا نظام الحكم في المغرب.الأول اتسم بالإقصاء والانغلاق، لأن النظام السياسي لم يكن مستعدا مطلقا لإشراك فاعلين من طينة مغايرة في تدبير الشؤون العامة. والثاني تميز بنوع من الانفتاح والرغبة في إقامة جسور تواصل وتفاعل مع من كانوا يعارضونه.
تأسيسا على هذه العناصر، انخرط الشارع في عملية تأييد كبرى لتجربة التناوب السياسية، سواء تم ذلك بصورة عفوية وحسية أو بصورة واعية. ما كان يهم في المسألة وقتئذ، هو إعلان الانتماء إلى معسكر المتفائلين المتطلعين إلى غد مشرق، تؤثثه القيم الديمقراطية والسلوكات العقلانية والمشاعر الوطنية التي تفجرها وتوجهها المصلحة العامة.
ولا أحد يجهل، أن جيوبا كثيرة للمقاومة أعلنت حالة استنفار قصوى، وحشدت أنصارها وميليشياتها لتنصب الكمائن، وتنسج المؤامرات ضد تجربة التناوب التوافقي. لأنها لمست فيها معولا سيهدم ما ثبتته من امتيازات وما راكمته من ثروات غير مشروعة. وأي استكانة أو خمود من طرفها سيفقدها مواقعها وقلاعها التي حصنتها ورعتها سياسة الإفساد التي خربت الوطن وجعلته مرتعا للتسول ووكرا للدعارة وفضاء مفتوحا لشتى أنواع الأميات، كما كانت تذهب إلى ذلك العديد من المواقف والآراء السياسية والإعلامية التي دافعت عن تجربة التناوب، ووقفت في وجه ما يصطلح على تسميته بأنصار الحرس القديم.
غير أن توظيف جيوب المقاومة دون تحديدها وتعيينها، خلق جوا من الغموض والالتباس. وربما سحب البساط من تحت أقدام حكومة التناوب التوافقي التي احتمت بهذا التوصيف والتوظيف ردحا من الزمن، لتبرير عجزها في تحقيق الوعود التي قطعتها على نفسها، بدءا بالتصريح الحكومي في البرلمان عام 1998،و الذي اعتبر تعاقدا سياسيا مع الشارع .وهذا الأخير ونظرا لتركيبته غير المتجانسة، ودرجة تسيسه غير المنهجية والمتدنية، لم يكن في استطاعته أن يطرح الأسئلة الجذرية التي تتجه رأسا صوب الهامش الدستوري المتاح للحكومة لتتخذ القرارات الجريئة والمجدية. وهذا ما دفع جزءا منه إلى سحب تأييده لتجربة التناوب، لأنه كان ينتظر تغييرات على الأرض تقنعه بأهمية القيمة المضافة لنفس التجربة. وعندما وجد أن الإدارات لم تصلح، وأن المؤسسات تحكمها نفس العقليات، وأن الرشوة والمحسوبية متفشية في كل مكان، وأن اللغة الإعلامية المتداولة في الإعلام العمومي موغلة في العتاقة والاستفزاز والتخلف. صدمه هذا المشهد،و أيقن أن الأمر لا يتعلق بتناوب سياسي حقيقي، وإنما بلحظة سياسية أعيد فيها ترتيب صناعة القرار لتأمين شروط إجماع وطني جديد، وإعادة هيكلة السلم الاجتماعي، بناء على مفاهيم منقحة ومكيفة وفق متطلبات العهد الجديد.
الملاحظ ،هو أنه عادة ما كان يصاب أنصار حكومة "التناوب" بنوبة من الغضب، عندما كان يقال لهم بأن الإنجازات التي تحققت على عهد حكومتهم لا ترقى إلى مستوى انتظارات الشارع. ولرد هذا الاتهام، كان يتسلح هؤلاء الأنصار بترسانة من الذرائع، في مقدمتها ما كان يعرف بـ "الإرث الفاسد والثقيل" الذي ورثته عن الحكومات السابقة. لكنهم مع ذلك كانوا يغفلون صرف النظر عن مسالك متعددة كان بإمكان حكومة عبد الرحمان اليوسفي أن تسلكها لتوطد وترسخ الأمل والثقة في الناس. من قبيل اتخاذ إجراءات عقابية ضد الذين عاثوا في المغرب فسادا، وضد الذين سرقوا المال العام، وعرضوا المقاولات التابعة للدولة للإفلاس بعد نهبها، وضد الذين لطخوا سمعة المغرب بتورطهم في اغتيال واختطاف واعتقال آلاف المواطنين والمعارضين. لو قررت حكومة التناوب إتباع هذا النهج وراهنت على هذا الخيار، و ولو ألحت على إعادة الأموال المختلسة إلى خزينة الدولة، لكسبت عطف ومساندة الشارع مائة في المائة. لكنها وعلى ما يبدو فضلت المهادنة وضبط النفس، تحت طائلة عدم إثارة الفتنة، وبتبريرات غير منطقية أحيانا، مفادها أن المغرب يجتاز مرحلة دقيقة، ويواجه خصوما في جبهات مختلفة. و الرأي السديد حسب تعليلها كان يقتضي التحلي بفضيلة التسامح، لاسيما وأن صدر المغرب واسع ورحب. والفجائع والمصائب التي ألمت به، واجهها برباطة جأش وبهمة عالية و خرج منها منتصرا مرفوع الرأس. وهذا ما تداركه الحكم، عندما أعلن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، لطي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة التي طالت حقوق الإنسان فيما يعرف بسنوات الجمر والرصاص.
أكيد أن السياق الذي انبثقت فيه حكومة التناوب التوافقي، لعبت فيه عوامل دستورية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية وإعلامية. لكن العمليات الجراحية التي أجرتها الحكومة، وخاصة على مستوى تخليق الحياة العامة، وإصدار بعض القوانين والمدونات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، لم تسوق إعلاميا وسياسيا. وشكل هكذا التواصل مع الجماهير أحد عناصر الضعف الكبرى التي قللت من مصداقية نوايا وخطاب الحكومة. وإذا كان من المفروض أن تعكس وسائل الإعلام العمومية ـ خاصة التلفزة ـ مضمون العهد السياسي الجديد وقيمه الساعية إلى الحداثة والعقلانية والكفاءة والنزاهة والإنتاجية، فإنها انفلتت من يد الحكومة، وتحولت في أحايين كثيرة إلى أداة تسيء إلى سمعتها، وتروج لغة مناهضة لها. ما يدل على أن الواجهة الإستراتيجية والحيوية التي كان على الحكومة أن تحررها من ربقة التحكم والاستبداد، ضاعت منها. وتبعا لذلك ضاعت إمكانية الوصول إلى الجماهير وتوصيل رسائلها بعيدا عن الديماغوجية والاحتكار وتمجيد الذات والمدح الرخيص لمنجزات عادية تدخل في نطاق الواجب. ولو وظفت حكومة التناوب جهودها على امتداد سنوات ولايتها، لإخراج قانون تحرير القطاع السمعي البصري إلى الوجود، وتفعيله ميدانيا، لسجلت لصالحها نقطة إيجابية سيذكرها لها التاريخ. بمعنى آخر، لو تم إقرار هذا القانون لوجدنا أنفسنا أمام مشهد إعلامي مغربي مغاير تماما، كان بإمكانه أن يعزز صورة إيجابية للحكومة، وأن يلعب دورا فعالا في تعميق ثقافة الديمقراطية والاختلاف في الرأي ونقل حقائق الواقع وتعرية مساوئه وأعطابه ومساحاته النتنة.
"نحن ليبراليون، لكن لانريد أن نذهب إلى أقصى الليبرالية"، هذا الكلام للمفكر المغربي المتميز عبد الله العروي، وهو يختزل في عمقه الرؤية المبتورة والانتقائية التي تتبناها الدولة المغربية في التعاطي مع الليبرالية، فعوض أن تتمثلها فلسفة سياسية، ومضمونا اجتماعيا، وخيارات اقتصادية، وقيما ثقافية، نجدها ـ أي الدولة المغربية ـ تستغلها فقط للتغطية على اقتصاد الريع والامتيازات التي فرخت مقاولات هشة، وعلاقات إنتاجية متخلفة.
والأخطر من كل هذا، هو الأسئلة الجارحة والحارقة التي طرحها ويطرحها قطاع عريض من الشارع حول جدوى الانخراط في السياسة والانتماء إلى الأحزاب والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وهذه الأسئلة ليست منحوتة من صلصال الوهم. أو مستوردة من الخارج، بل هي تقيم في العقل الجماعي المغربي، ولها ما يبررها تاريخيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا. وأعتقد أن الأمر عندما يتعلق بمصير مشترك، فإنه ينبغي على كل الفاعلين مهما كان موقعهم أن ينصتوا قليلا إلى نبضات الشارع، وأن يعيدوا ترتيب أوراقهم وأولوياتهم، وأن ينتفضوا ولو لمرة واحدة ضد أوهامهم.