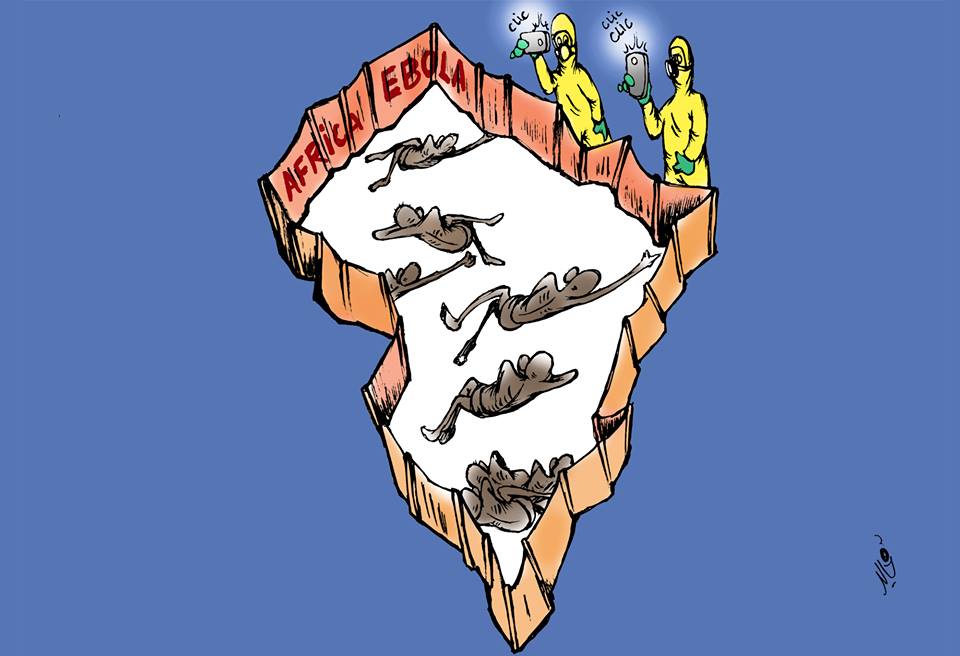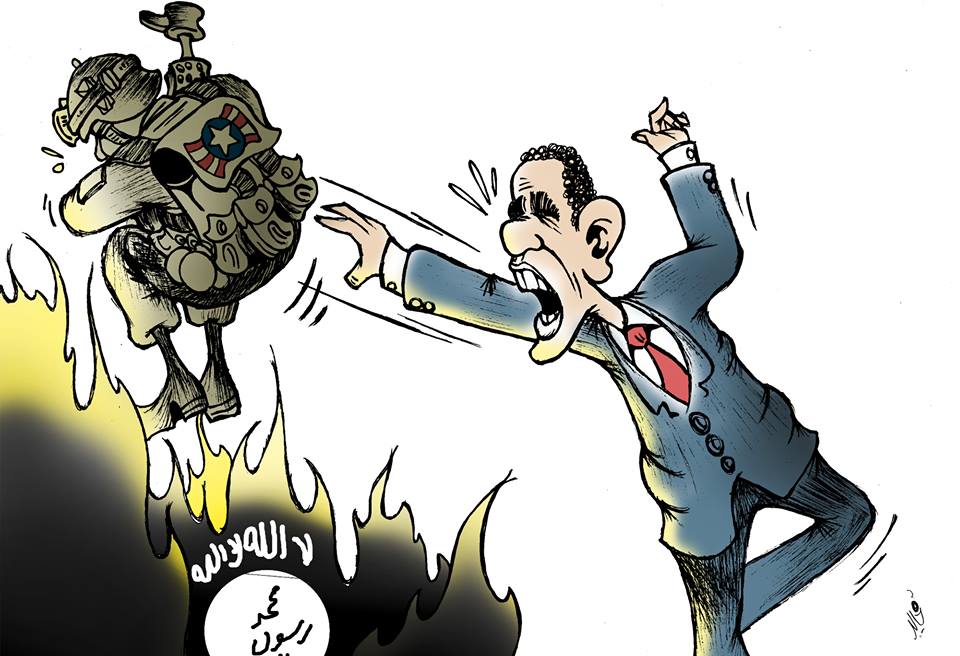المغرب : مفارقات لغوية
بقلم :عبدالصمد بنشريف
في المغرب لا نفهم مطلقا أي لغة تكتسي طابع الدستورية، فالواقع ينطق بممارسات مغايرة بشكل جذري لما هو موجود في الوثيقة الدستورية، ذلك أن اللغة الفرنسية هي أداة التعامل الرسمية، في الإدارة وأغلبية القطاعات، وليس هناك من المسؤولين والموظفين ، من لا يتواصل ويتخاطب بلغة موليير، بل تجد من يحقق ذاته وكينونته الاجتماعية، عبر هذه اللغة الجميلة والشاعرية.
فالمسألة ليست مقتصرة فقط، على خيار لغوي معين، فرضته ظروف وسياقات تاريخية وتعليمية، بل هناك إرادة معلنة لدعم اللغة الفرنسية، وجعلها لغة الحياة اليومية والتواصل في كل المؤسسات. مع العلم أن تمركز هذا السلوك اللغوي "الفرنسي"، يوجد بكيفية خاصة في ما يعرف بالمغرب النافع، وتحديدا الدار البيضاء والرباط، وبطبيعة الحال، ليس كل سكان هذا الشريط، يتحدثون اللغة الفرنسية. أما المغرب الآخر، فله نظامه اللغوي، الذي ربما يبدو بالنسبة لنخب الرباط والدار البيضاء، الناطقة بالفرنسية، متخلفا ولا يرقى إلى مستوى الأنظمة اللغوية، التي تتوفر على مقومات الإبداع، والسلاسة في التعبير، والدقة في القصدية، والسهولة في التواصل، والوفرة في المصطلحات، إلخ
لكن الجديد في الأمر، هو أن المفارقات اللغوية، أخذت منحى عبثيا، وبعدا شعبويا في المغرب، وانطلقت المبادرات الساعية إلى دعم العامية المغربية، وتحويلها إلى لغة الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
ويبدو أن شعار" تدريج" الفضاء اللغوي في المغرب، والانتصار لخيار العامية، ليس بريئا ، فهو وإن كان يتذرع بمبدأ تحقيق التواصل، وتمكين المغاربة من فهم بعضهم البعض، ومنحهم شرطا من شروط الاندماج في الفضاءات اللغوية النقية والمتقدمة، فإنه ـ أي خيار دعم العامية ـ لا ينفصل عما تتزعمه مجموعة من المؤسسات الغربية، وما تقوم به من تبشير لغوي، يوهم بأنه في صالح الحداثة اللغوية ومع تكسير الطابوهات المقدسة، التي كرست الانغلاق والجمود والتخلف
بصراحة شديدة، أعتقد أن هذا الرهان خاسر، وغير مقنع، ويدفع بنا إلى الوراء. ليس بهذه السهولة، يمكن أن نحل الإشكال اللغوي، إذ لا بد من مقاربة شمولية، ولابد من قرارات وإرادات، فاللغة تتطور وتتقدم باستعمالها في كل المجالات، وأنا هنا، لا أقصد بالضرورة اللغة العربية، بل أي لغة. كما أن الحد الأدنى من احترام حق المواطن، في التواصل بلغته، يعطي للغة عمرا إضافيا
فكيف يعقل أن لايعرف المواطن، الذي لا يعرف أو لا يتقن الفرنسية، ما تحتوي عليه علب الأدوية والمواد الغذائية، والصناعة الإشهارية، والمذكرات والمراسلات، والوثائق البنكية
أنا أتحدث هنا بعيدا عن أي تعصب أو شوفينية لغوية، وأردت فقط أن أشير إلى عدم عقلانية ما يطرحه المتشددون الجدد، في تيار الدفاع عن خيار العامية ، ضاربين بمنطقهم التجاري والربحي، مصداقية أي نقاش يمكن أن يثيروه حول الحق في اللغة واللغة التي يجب أن نتواصل بها دون أن نشعر بالنقص أو نساهم في إنتاج اللاتواصل وتجزيئ المجتمع إلى جزر لغوية.
. فسطوة وهيمنة اللغة الفرنسية أصبحت معطى ملموساً، وأنصارها يتناسلون ويتزايدون بأعداد هائلة، لأن الكل مدرك أنه بدون التحدث باللغة الفرنسية، ربما سينظر إليه نظرة ناقصة، وقد لا يجد له مكاناً في سلم الرقي الاجتماعي والقيم المشتركة بين الكتلة الناطقة بالفرنسية، خصوصاً أن الدولة المغربية لا تتعامل في مجمل مرافقها ومؤسساتها ومراسلاتها سوى بالفرنسية، وحتى الخطب والتقارير التي تحدد الاختيارات وترسم الاستراتيجيات الكبرى تحرر بالفرنسية، ثم تترجم إلى العربية، من أجل ذر الرماد في عيون شرائح واسعة من المجتمع.
ومعظم الخطب التي يلقيها العديد من الوزراء في بلد كالمغرب تلقى بالفرنسية، وكأنها موجهة إلى جمهور فرنسي. وعندما يدلي هؤلاء بتصريحات إلى وسائل الإعلام، خاصة التلفزيون، فإنهم يحرصون على أن يفعلوا ذلك بفرنسية تنم عن تشبثهم بشروط ومعايير الانخراط في صف الحداثة والديمقراطية!
هذا «السلوك» اللغوي يثير حفيظة الأغلبية الساحقة في المجتمع المغربي، لأنها ترى فيه استهتاراً بمكونات الهوية الثقافية والحضارية المغربية، التي تعتبر العربية إلى جانب الأمازيغية، إحدى مقوماتها الأساسية، وتشعر هذه الأغلبية بأقصى درجات الاستفزاز عندما تلاحظ أن «فرنسة» الحياة في المغرب، عوض تعريبها أو تمزيغها ليست صدفة أو بالأمر الغريب، بل هي إجراء وخيار منهجي مفكر فيه، يبتغي الحفاظ على مواقع وامتيازات وروابط نخبوية، لكنها تقليدية، مع صناع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والإعلامي في فرنسا.
وليس مفارقة أن ينخرط رجال الأعمال المغاربة حتى النخاع في المناخ الفرنسي، فهم حسموا خياراتهم اللغوية والثقافية، وباتوا يتواصلون في اجتماعاتهم وعلاقاتهم، حتى خارج مقرات عملهم، باللغة الفرنسية، بل يرفضون مبدئياً التحدث بالعربية أو حتى العامية المغربية .
واللافت للنظر أيضاً أن صناعة الإعلان في المغرب يهيمن عليها بشكل يكاد يكون مطلقا، المنتصرون لـ «خيار فرنسة المغرب»، فالإعلانات التي يبثها التلفزيون أو تلك المثبتة فوق جدران البنايات، أو المنتشرة في أهم شوارع المدن المغربية، معظمها مكتوب بالفرنسية، باستثناء بعض المواد الاستهلاكية الأساسية التي يفترض أنها موجهة إلى عموم الشعب، وكأن هذه الإعلانات تستهدف الفرنسيين، وهذا ما يمثل سلوكاً تجارياً وتواصلياً ينطوي على كثير من الانتهازية لأنه يستغبي المواطن برأي بعض المراقبين ويحتقره، علما أن هذا المواطن هو المستهدف تجارياً وتواصلياً واقتصادياً.
وحتى المستشفيات التي يفترض أن تعتبر مؤسسات إستراتيجية من الدرجة الأولى، لا تجد فيها أثراً للغة غير الفرنسية، وكأن جحافل المرضى القادمين من المناطق النائية، يتحدرون من باريس أو بروفانس أو كيبيك. والشيء نفسه ينطبق على المؤسسات المصرفية، فكل الوثائق مهما صغرت قيمتها، تنجز باللغة الفرنسية، رغم أن جزءاً كبيراً من الزبائن لا يلمون بهذه اللغة.
وأسوأ ما في الأمر أن الموظفين وأصحاب الوظائف العليا والأطباء والصيادلة والمهندسين ومدراء الشركات والجيل الجديد من التكنوقراطيين، يميلون بكل حماس إلى تداول اللغة الفرنسية. ولا يحرج هؤلاء في شيء أن يتجاهلوا مواطنيهم ومقتضيات التواصل مع محيطهم. ويكتفون بإجابة واحدة عندما تثور في وجوههم أسئلة من هذا النوع، مفادها أن المسألة تتعلق بعادة لغوية، أي أن الموظفين والمسؤولين مهما علت أو دنت مراتبهم تعودوا على الحديث بالفرنسية، لا أقل ولا أكثر.
وتبقى النقطة التي تتمحور حولها كل الأسئلة المقلقة، وهي الاختلالات التي أنتجتها الخيارات التعليمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي دافعت عنها النخب الحاكمة منذ عقود عدة، لأنها لمست أن مصلحتها وهيمنتها الطبقية، تكمن في انتعاش واتساع رقعة محيط لغوي يتداول الفرنسية، وينتمي شكليا إلى القيم الفرنسية.إضافة إلى هذا، لم تكن هناك سياسة لغوية حقيقية قائمة على مخطط محدد الأهداف، مما أحدث اعوجاجاً وتشوهاً في المنظومة التربوية، ووجد الطلاب أنفسهم في متاهة لا بداية ولا نهاية لها، بل أفرزت تجارب التعريب في المغرب حالة من الانفصام في صفوف الأجيال الجديدة، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى الأوساط الشعبية.
أما المنتصرون لخيار فرنسة المغرب والدوائر المرتبطة بهم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فإنهم لم يواجهوا إشكالية تربوية أو لغوية من هذا القبيل، لأنهم ببساطة يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية، والفرنسية تحديداً، وبعد ذلك يواصلون تعليمهم في المعاهد والجامعات الغربية، وعندما يعودون إلى المغرب متوجين بشهادات عليا في مختلف التخصصات، يجدون المناصب في انتظارهم، لأنه تمت تهيئتهم أصلا ليتولوا تدبير الشأنين العام والخاص، ولا يقض مضجعهم شبح البطالة كما هو الشأن بالنسبة لنظرائهم الذين درسوا في مؤسسات التعليم العمومي، والذين يقضون الآن معظم أوقاتهم في الاعتصام والاحتجاج أمام البرلمان .إن الذين يظهرون اليوم قلقا على المستقبل اللغوي في المغرب، ويتألمون لما يلاحظونه من تيه وشيزوفرينا لدى المغاربة، هم من يجد لذة استثنائية في التحدث باللغة الفرنسية، وعندما يرافعون من أجل استعمال الدارجة المغربية، فإنهم ينافقون، فهم أصلا لا يتحدثون بها، أو يعتبرونها لغة غير راقية وغير حية، ومن ثم، فهي لاتليق بلسانهم.
والغريب في الأمر، هو ما ذا يمثل هؤلاء أشخاصا ومؤسسات؟ ولماذا يختزلون أزمة التعليم في الجانب اللغوي؟وهل يملكون من الشرعيات ما يجعلهم يتبنون طرح إشكالية اللغة في المغرب؟
أعتقد أنه، ولكي لانضيع الوقت في سجالات ومزايدات لاطائل من ورائها تغذي الصراعات وتنتج عدم الاستقرار، يجب التفكير في تنظيم استفتاء شعبي يحسم في اللغة التي ينبغي أن تكون لغة التعليم والتعامل والإعلام في المغرب.
تنويه:هذا المقال هوتركيب لنصين نشرا منذ سنوات .وأعيد نشرهما على خلفية الجدل الدائر حول الخيارات اللغوية التي يجب اعتمادها في المغرب